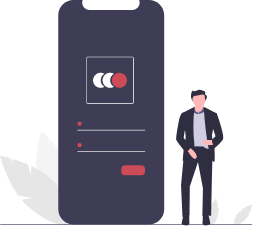
تسجيل دخول
لطفاً, أدخل بياناتك لتتمكن من تسجيل الدخول
إسترداد كلمة المرور
لطفاً, أدخل بياناتك لتتمكن من إسترداد كلمة المرور
تسجيل حساب جديد
لطفاً, أدخل بياناتك لتتمكن من تسجيل حسابك
بواسطة: أوراق الفعاليات، تاريخ النشر: الأحد 03 - ديسمبر - 2017 07:31 صباحاًً
قرأت 1150 مرات
1153 مشاهدة
بداية الفعالية
1439-03-15
03-12-2017
الأيام المتبقية 0 أيام
نهاية الفعالية
1439-03-15
03-12-2017
الأيام المتبقية 0 أيام
آخر موعد لاستقبال الملخص
1439-05-26
Y-M-D
الأيام المتبقية 0 أيام
الإبلاغ بالملخصات المقبولة
1439-05-26
10-02-2018
الأيام المتبقية 0 أيام
آخر موعد لاستقبال المشاركة
1440-04-17
Y-M-D
الأيام المتبقية 0 أيام
الإبلاغ بالمشاركات المقبولة
2018-08-01
01-08-2018
الأيام المتبقية 0 أيام
ينظمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمعهد العالي للحضارة الإسلامية ووحدة بحث دراسات قرآنية معاصرة /جامعة الزيتونة-تونس
أولاً: فكرة المؤتمر
يتزايد في الآونة الأخيرة ظهور صيغ جديدة لنسج معالم الإنسان ضمن الإحداثيّات الزمانيّة والمكانيّة التي تكتنفه في سياقه التاريخي. ومثل هذه الصيغ تنطلق في تحديد معالم الإنسان المنشود من خلال جملة معايير وضوابط مرجعيّة تحمل في كنفها هندسة عميقة لمقوّمات التعامل مع الإنسان بقدر ما ينحدر نحو التعدّد والتنوّع، وهو ما يفترض مناهج من التعامل مع كلّ أنموذج في سياقاته المكانية والفكريّة والحضارية.
وما من شك في أن ثمة مفارقة بيّنة بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي في النظر إلى الإنسان وتأسيس النظريات العلمية والعملية المتعلقة به؛ إذ برز في الفكر الغربي خلل منهجي وتصوري في تفحّص الإنسان، مما أفقد الإنسان مكانته الاستخلافية المكرمة؛ إذ اختزلت هذه النظريات الإنسان في بُعده المادي فغدا إنساناً طبيعياً مادياً، وأصبح يُعرّف في إطار مقولات صراعية حول الوظائف البيولوجية، والدوافع الغريزية، والمثيرات العصبية إلخ. وجاء تيار الأنسنة ليثبّت مفهوم مركزية الإنسان في الكون (وخاصة الإنسان الأبيض)، وأن الإنسان هو مرجعية ذاته، وهو الوحيد القادر على إنتاج القيم والأخلاق؛ فأخلاق الإنسان هي ما يقرره الإنسان. ثم جاء فكر ما بعد الحداثة ليقضي على المرجعية والمركز من خلال التفكيك والعدمية؛ مما يفسر حالة الإلحاد التي تجتاح المجتمعات الغربية خاصة. وبناء عليه، ما المرجعية التي اتكأت عليها تيارات الفكر الغربي في إنتاج صورة الإنسان؟ وما المقاربات المعرفية التي نشأت في عالمنا العربي الإسلامي في إنتاج الصورة ذاتها؟
ولعلنا نلحظ أن مجتمعاتنا قد غدت حقلاً للتصارع بين كلّ الأطروحات التي تسوّق وتشرّع لصورة الإنسان؛ فهناك الصورة المتسلّلة من تراكمات التراث، التي عزّزت من مكانة التقاليد، واختزلت الوجود في صيغه المنصرمة من دون إقدام على التوليف الإجرائي بين لحظات الزمن الثلاث: الماضي والحاضر والمستقبل، فباتت صورة الإنسان تتنافى والمنهج الاستخلافي المؤسّس للإنسان- الخليفة. وثَـمَّة نماذج الجدل بين أنصار الأنسنة المؤمنة وأنصار الأنسنة "الهيومانية" المتحرّرة من مرجعيّة الوحي. ومنها نماذج انبثقت عن تعامل تاريخي-نقدي مع متعلّقات الموروث الثقافي والديني للذات أو الآخر المختلف، وولّد نماذج فكريّة بشحنات إيديولوجية غريبة عن الفضاء القيمي القرآني. ومنها مراجعات فكرية متشنجة تحوّلت إلى حقل السجالات السياسية جعلت صورة الإنسان خاضعة للخيارات السياسيّة والإملاءات الوافدة، إلى درجة التعسّف في قراءة النصوص المرجعيّة من قرآن وسنّة وسيرة وما تعلّقت بها من أحكام شرعيّة، فتحوّل التشريع من الوحي إلى العقل ومن الإلهي إلى الإنساني، إلى درجة الوصول إلى تأسيس للنموذج الدنيوي للإنسان يثبت مفهوم تاريخانية النص القرآني. فما هي أهم المراجعات الفكرية التي تمت حول صورة الإنسان في الفضائين: القيمي القرآني والفضاء المتصادم معه؟ وما الخلل المنهجي الذي اعترى مدرستي الاستنساخ والإسقاط؟ وما تمثلاته في البيئة المجتمعية؟ وما السمات الأساسية للمنهج القويم الذي نحتاج إلى ممارسته لفك الاشتباك بين تراكمات التراث وقبضة الطارئ المتفوق بعُدَّته المدنية والثقافية، والاحتفاء بخصوصية الزمان والمكان والفعل والمخاطَب؟ وما المتطلبات اللازمة لتحقيق التمكن والاستيعاب والمراجعة والتجاوز؟
لقد أظهر الفكر الإسلامي في أصوله التأسيسية (القرآن الكريم والسنة النبوية) والفعل التراثي المتسق مع النص معالم مميزة لصورة الإنسان مفارقةً للرؤية الغربية، ومكانته في الرؤية الكلية، ومكانته في منظومة القيم العليا الحاكمة (التوحيد والتزكية والعمران)، ودوره الاستخلافي الذي كرمه الله به، وغائيته في هذا العالم. فجاءت هذه الصورة على مسافة واضحة تفصله عن المتعالي المتجاوز على حد تعبير المسيري مما يمنحه الحرية المسؤولة، ولكنّه يشترك مع الكائنات الأخرى في بعده المادي مما أسماه عبد المجيد النجار بوحدة التكوين، فهو تجليات مكونين: روحي/مادي. وبناء عليه، ما تجليات هذه الرؤية الإسلامية الحضارية في فعل الاستخلاف البشري في الأرض؟ وما انعكاساتها على بناء الشخصية الإسلامية القادرة على الفعل الحضاري؟
إن صورة الإنسان كما يستهدفها الوحي الإلهي ويمارسها الهدي النبوي لا تفارق مكانة التكريم والتزكية، لجسمه وعقله وروحه، في المال والبنين والأسرة، وفي الفرد والمجتمع والأمة، حتى إننا نرى التزكية قيمة حاكمة عليا لا تنفك عن قيمة التوحيد وقيمة العمران. وبين هذه القيم الثلاث: التوحيد والتزكية والعمران من وشائج التداخل والتكامل ما يقدم للإنسان صورة عن نفسه تمتلئ بالثقة والقدرة على تحقيق مقاصد الحق من الخلق. والمقصد الأعظم من التشريع الرباني لحياة الإنسان في هذا العالم –كما يقول الطاهر بن عاشور- هو جلب الصلاح ودرء الفساد، وذلك يحصل بإصلاح حال الانسان ودفع فساده؛ فهو المهيمن على هذا العالم، وصلاح أحواله صلاح أحوال العالم. ولذلك ربطت مقاصد الرسالة الربانية الخاتمة بين تلاوة الكتاب، والتزكية، وتعليم الكتاب والحكمة. فعن التزكية التي يتحقق بها الإنسان في عقله ونفسه، تنبثق سائر أفعاله وتصرفاته وأساليب حياته، ومن دون هذه التزكية يختل بناء العمران البشري كما أراده الله وتتوجه حركة الحياة والحضارة في اتجاهات تصادم فطرة الإنسان، وينتشر الفساد، ويسود الظلم، وتنعدم العدالة. فكيف نفهم نصوص الوحي الإلهي والهدي النبوي حول مفهوم التزكية، وقيمة التزكية وتكاملها مع القيم الأخرى، وانعكاسات هذه القيمة على صورة الإنسان في الفكر الإسلامي والنهوض الحضاري المنشود؟
لقد أسهمت النظريات الاجتماعية والفلسفية الغربية المادية في مسخ الشخصية الإنسانية عامة، وحصرها في بُعد أحادي كما عبّر عنه بعض المفكرين الغربيين، انطلاقاً من مركزيّة غربيّة استعمارية ترسّخ صورة الإنسان الغربي المتفوق والأسمى. ونحسب أن البدائل المنشودة لهذه النظريات كامنة في النَّصِّ القرآني عند استرجاع مفهوم الآدميّة والتعارف والمشترك الإنساني. وقد قدم بعض المفكرين المحدثين والمعاصرين المسلمين تصورات معرفية وثقافية للإنسان بشكل عام والإنسان المسلم بشكل خاص ضمن مشروع حضاري يهدف إلى التخلص من قيود النظريات الغربية. ونذكر من هؤلاء المفكرين على سبيل المثال لا الحصر: الغزالي، وإقبال، ومالك بن نبي، والفاروقي، وعلي شريعتي، وبيجوفيتش، وجارودي، والمسيري، وعبد الحميد أبو سليمان، إلخ. فهؤلاء تجمعهم مدرسة فكرية توحيدية تكاملية تستعيد صورة الإنسان بطبيعته الاستخلافية المزدوجة المادية/الروحية التي توظف مناهج مركبة. وكان لهذه الجهود موقعها في مثاقفة النظريات الحديثة والعودة إلى الذات، في سبيل تأسيس متن عربي إسلامي في التعامل مع الإنسان وتفحّص ماهيته ومكانته ومقصدية وجوده مع توظيف نقدي رشيد للمنتج المعرفي البشري. فما معالم المشاريع والبدائل المعرفية النهضوية الحاضرة في الساحة الفكرية المعاصرة؟ وما دورها في البناء الحضاري؟ وما سمات المناهج التي تقترحها في سبيل رسم صورة الإنسان؟
هذه إشكاليّات تحتاج إلى النظر والدراسة والمراجعة، والتناول العلمي الرصين، وتقديم رؤى تحليليّة ونقديّة، بغية إنشاء صورة حضارية للإنسان-الخليفة ووضعها في مناطق الضوء، لتكوين خطاب إصلاحي مؤسس على الانفتاح والتواصل والحوار يكون بديلاً عن ردود الفعل المتشنجة والمقاربات التبسيطيّة-المختزلة للخروج من شرنقة الأزمات الحافَّة بأنموذج الإنسان.
ثانياً: أهداف المؤتمر
ثالثاً: محاور المؤتمر
المحور الأول: مفهوم الإنسان ومكانته في النصوص التأسيسية والتراث
المحور الثاني: مقصد القرآن في تحقيق تزكية الإنسان
المحور الثالث: مفهوم الإنسان ومكانته في الفكر الغربي المعاصر
المحور الرابع: سؤال الإنسان في الفكر الإسلامي المعاصر
المحور الخامس: سؤال الإنسان والهوية وبناء المجتمع
المحور السادس: تجارب وخبرات عملية في المحافظة على الصورة القويمة للإنسان في الحاضر والمستقبل
رابعاً: مواصفات الأوراق المطلوبة


مجانية
| عنوان الجلسة | التاريخ | المكان | رئيس الجلسة | تبدأ في | تنتهي في | التفاصيل |
|---|
| رقم اللجنة / كود اللجنة | اسم اللجنة | رئيس اللجنة | التفاصيل |
|---|
| الاسم | البريد | رقم الجوال |
|---|
| رقم القائمة / كود القائمة | اسم القائمة | التفاصيل |
|---|
| رقم المعرض / كود المعرض | اسم المعرض | من | الى | التفاصيل |
|---|
| رقم الفقرة / كود الفقرة | اسم الفقرة | المتحدث الرئيسي | من | الى | التفاصيل |
|---|
| الاسم | التعليق | التقييم |
|---|
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تعليقات
0 تعليق