منصة أوراق الفعاليات
موقع إلكترونيّ لإنشاء الفعاليات وإدارتها إلكترونياً، وإعداد ما يلزمها من بطاقات وشهادات حضور ونحوها، وعرض جميع إجراءاتها الأخرى، مع السعي ليكون موقعاً متفرّداً في الفعاليات بأنواعها.

دورة (لاميّة العرب للشنفرَى)" مع أ.د. عبدالعزيز بن علي الحربي
مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، بالتعاون مع معهد سيبويه لعلوم العربية
مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية
برسوم
2020-10-24 - 2020-10-25

الدورة التدريبية (مقدمة في التحليل الاحصائي باستخدام برنامج SPSS)- ماليزيا
المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات- ماليزيا بالتعاون مع المركز الأكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي- ماليزيا ومركز الخوارزمي للدراسات والاستشارات التربوية– سلطنة عمان
كوالالمبور، ماليزيا
مجانية
2020-10-26 - 2020-10-26
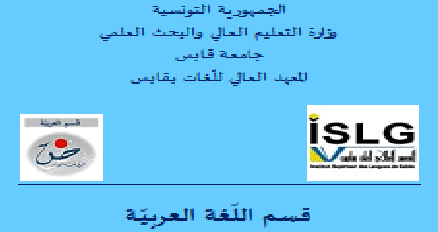
الندوة الدولية الرابعة (العربيّة وسؤال القيمة)- تونس
قسم اللغة العربيو بالمعهد العالي للّغات جامعة قابس- تونس
قابس، تونس
برسوم
2021-03-03 - 2021-03-04

الملتقى الدولي العلمي الهندي العربي الأول (عن بعد)
مجموعة مراكز علمية
نيودلهي، الهند
مجانية
2020-10-24 - 2020-10-25

استكتاب (اللسانيات الجنائية ودورها في تحقيق العدالة)- ليبيا
مجموعة من الأساتذة في جامعة بنغازي- ليبيا
بنغازي، ليبيا
مجانية
2020-09-01 - 2021-04-01
المؤتمر الدولي (منظومة القيم في التعليم الجامعي: نحو رؤية جديدة للإصلاح التعليمي)- الإمارات
المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية
Abu Dhabi، الإمارات العربية المتحدة
مجانية
2020-11-22 - 2020-11-22

الاستكتاب الدولي (الدرس اللساني والبلاغي الحديث، مبادئ ومفاهيم وإجراءات)- الجزائر
مجموعة من الأساتذة
الجزائر، الجزائر
مجانية
2020-10-02 - 2020-12-15

ملتقى السرديّات بمدنين، الدورة السابعة بعنوان (السرد والبحر)- تونس
الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين بالتعاون مع جمعية الرابطة القلمية بمدنين
مدنين، تونس
مجانية
2020-10-14 - 2020-10-15

ورشة عمل (امتحان الكفاءة اللغوية، ممارسات فاعلة ومفاهيم غائبة- د. غازي أبو حاكمة)-
معهد سبيل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
عمّان، الأردن
برسوم
2020-10-24 - 2020-10-24

محاضرة علمية (نموذج مستعملي اللغات الطبيعية .. آفاق جديدة في البحث الوظيفي العرفاني)- أحمد عبد المنعم
حلقة اللسانيات والخطاب بنادي أبها الأدبي
أبها، المملكة العربية السعودية
مجانية
2020-10-06 - 2020-10-06

لقاء علمي (تجارب دولية للتعليم الجامعي في زمن الجائحة)- قطر
الملتقى القطري للمؤلفين
الدوحة، قطر
مجانية
2020-10-08 - 2020-10-08

استكتاب لإصدار كتاب جماعي بعنوان (مشكلات البحث العلمي في الوطن العربي)- ألمانيا
المركز الديمقراطي العربي
برلين، ألمانيا
مجانية
2020-09-01 - 2021-05-30
لا يوجد فعاليات قائمة الأنً
لا يوجد فعاليات كبرى الأنً
لا يوجد فعاليات صغرى الأنً
لا يوجد فعاليات طويلة الأنً
لا يوجد فعاليات ترفيهية الأنً
أول منصة لإنشاء الفعاليات وإدارتها بكل أحداثها إلكترونياً
إنشاء فعالية
تتيح هذه الخدمة لمنظم الفعالية إنشاء الفعالية على الموقع وإضافة جميع تفصيلاتها وملفاتها المرافقة
إدارة فعالية
تتيح هذه الخدمة لمنظم الفعالية إدارة فعاليته بجميع تفصيلاتها والتواصل مع المشتركين
الحملات الإعلانية للفعاليات
تتيح هذه الخدمة لمنظم الفعالية إبراز الفعالية بحملة إعلانية تزيد من ظهورها في الصفحات الإعلانية.
يضم الموقع مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة، والجهات المنظمة، وعدداً أكبر من أعضاء الموقع
539
عدد الجهات المنظمة للفعاليات
يضم موقعنا 539 من الجهات المنظمة التي أنشأت فعاليات وتقوم بإدارتها بإجراءاتها المختلفة
1713
عدد أعضاء الموقع
عدد أعضاء موقعنا 1713 ممّن يتابعون الفعاليات ويتفاعلون معها
789
عدد الفعاليات في الموقع
يضم موقعنا 789 من الفعاليات بكل أنواعها وتخصصاتها، وهي في ازدياد دائم
أول وأفضل منصة لإنشاء وإدارة الفعاليات بشكل إلكتروني متكامل
28.02.2020
الموسوعة الدولية للمختصين والمهتمين باللغة العربية
موسوعة دولية للسير الذاتية للعلماء والمختصين والباحثين والمهتمين باللغة العربية من مختلف دول العالم يحق لجميع المختصين والمهتمين باللغة العربية إدراج سيرهم الذاتية في الموسوعة بدون أي شروط، وبدون العضوية في الاتحاد الدولي للغة العربية أهلاً وسهلاً بكم في الموسوعة الدولية للمختصين والمهتمين باللغة العربية تهدف الموسوعة إلى توثيق السير الذاتية للمختصين والمهتمين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم تقديراً لجهودهم في خدمة اللغة العربية واهتمامهم بها وتضامنهم معها، إضافة إلى التعريف بهم وتحقيق التواصل بينهم للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في النهوض باللغة العربية لا يترتب على إضافة سيرتكم الذاتية وصورتكم الشخصية في الصفحة الخاصة بكم على موقع الموسوعة أي إلتزامات، كما أن الموسوعة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه ما يرد في سيركم الذاتية من معلومات، أو ما ينتج عنكم من أقوال أو أفعال أو ممارسات تتنافى مع السياسة العامة للموسوعة https://alarabiahunion.org
25.02.2019
قضية تيسير النحو العربي بين الحقيقة والوهم . الدكتور تجاني حبشي
الدكتور تجاني حبشي جامعة الجلفة– الجزائر- Habchi tedjani :Der University of Djelfa , Algeria إن الدعوة إلى تيسير النحو وتسهيل تعليمه دعوة قديمة جديدة. فهي من جهة قديمة دعا إليها النحاة الأوائل بعيد مرحلة التأسيس، فالمتتبع لنشأة النحو ومساره يجد أن بذور هذه الدعوة ظاهـرة في مؤلفات النحاة القـدامى أمثال: أبي عمر صالح بن إسحاق الجـرمي(ت225ه) في كتابه" مختصر نحو المتعلمين" وأبي عباس محمد بن يزيد المبرد (ت285ه) في كتابه" المدخل في النحو"، ومحمد بن كيسان (ت299هـ) في كتابه"مختصر في النحو"، والزجاجي(ت337هـ) من خلال مؤلفه"الجمل"وأبي جعفر النحاس (ت338هـ) من خلال كتابه" التفاحة في النحو"، وأبي بكر الزبيدي(ت379هـ) في كتابه " الواضح في علم العربية"، وابن جني(ت392هـ) من خلال كتابه" اللمع في العربية". وحقيق بنا أن نشير هنا إلى أن محاولات هــؤلاء هي محاولات صادقة، تـنم عن حبهم للغة العربية وغيرتهم عليها، وليس أدل على ذلك من أنهم كانوا يسعون لتقريب النحو من المتعلمين، علماً منهم أن النحو فيه بعض التعقيد، ولذلك كانوا ينتقون من مواضع النحو المبثوثة في الكتب المفصلة ما يناسب المستويات التعليمية، ويتجنبون التعمق والإطالة ويستعينون على توضيح القواعد والأحكام بالشواهد البسيطة الواضحة. غير أن الثورة الحقيقية على نهج النحاة القدامى هي تلك التي تبنتها طائفة من النحاة المتأخرين والتي مست بعض الأسس التي بنى عليها الأقدمون قواعدهم و رتبوها مطالبة بإلغاء بعضها، أو حذف بعضها الآخر، الأمر الذي جعل ورثة هذا العلم ينكر تلك الثورة، ويقابلها بعنف ويصنفها عقوقا لجهود الأوائل ولعل ابن مضاء القرطبي (592هـ) أكثر أولئك الثائرين في وجه النحاة، منكرا بعض قياساتهم لاسيما العقلية منها وقد أعتبر كتابه" الرد على النحاة" أخطر محاولة نقدية للنحو العربي، بحجة إصلاحه وتيسيره كيف لا؛ وقد انطلق صاحبها من مذهبه الظاهري، فانتقـد بعض نظريات النحو كنظرية العامل و الأقيسة النحوية، وفكرة الحذف والتنازع في العمل والتعليل وغيرها متهما إيـاها بالقصور. يقول عبده الراحجي موضحا الغاية من وراء تأليف هذا الكتاب: »وقد كتب كتابه يهدم فيه الأصول التي قام عليها النحو العربي في المشرق، وليس عجيبا لدى المتتبعين للفكر الإسلامي أن يتصدى ابن مضاء لنقد النحو العربي، فالحق أنه يكن يقصد هدم النحو لذاته وإنما كان يهدف إلى هدمه باعتباره وسيلة لفهم الفقه المشرقي الذي اشترك هو في الثورة عليه«.1 ومن جهة ثانية فهي دعوة جديدة؛ حيث اتجه هذا الاتجاه بعض اللسانيين العرب المحدثين مصورين للناس أنهم يقدمون شيئا جديدا على النحو العربي ومنهم على سبيل الذكر شوقي ضيف(1910/2005) الذي يعد من أوائل اللسانيين في القـرن العشرين الذين فجروا قضية تيسير النحو ودعوا إلى ضرورة إعادة النظر في مسلماته ومسائله. وكذلك فعل إبراهيم مصطفى الذي أصدر كتابه"إحياء النحو"على أساس هدم نظرية العامل. 2وقد تركزت أهدافه في عدد من الأمور منها: أنه كشف فيها ما قصر فيه النحويون وما زعموا، وما أثبتوا، وأبان عن رأيه في نقض كثير من ذلك وكان قاسياً على النحاة المتقدمين جميعا هاجمهم في غير مواربة ، وطعنهم في غير ليـن ولا رحمة ، لكن هذا الكتاب في نظر عبده الراحجي لم يؤد إلى النتائج التي كان يهدف إليها أصحاب التجديد.3 ثم توالت المؤلفات في هذا الصدد ذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر كتاب " اللغة العربية معناها ومبناها " لتمام حسان وكتابي" في النحو العربي، نقد وتوجيه" و"في النحو العربي، قواعد وتطبيق" لمهدي المخزومي وكتاب "مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب " لأمين خولي... وغيرهم ، كما عمدت بعض الهيئات العلمية العربية إلى دعم أفكار هـؤلاء ، بعقـد العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات في أنحاء مختلفة من العالم العربي، نذكر منها ندوة تيسير تعليم النحو، نظمها اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية سنة 1976م. وتجدر الإشارة هنا؛ إلى أن أقل ما يمكن أن يقال عن هذه المحاولات أنها محاولات قاصرة ، تـنم عن سوء الفهـم وانعدام التـقـدير، فقد زعموا أن في النحو العربي قصورا يوجب الإصلاح، ويدعو إلى إعادة النظر في بعض نظرياته . يقول عبده الراجحي مبينا الخلط و التخليط الذي وقعوا فيه إذ جمعوا في نظره بين النحو وتعليم النحو:» من أجل ذلك جرت محاولات غير قليلة لإصلاح النحو أو تيسيره ، لكنها جمعيها أخطأت البداية فلم تصل إلى الغاية ، ذلك أنها ظنت أن تيسير النحو يسر تعليمه وهذا غير صحيح ، فقد بينا أن ثمة فـرقا جوهــريا بين النحو وتعليم النحو، الأول علم النحو وهو علم يقـدم وصفا لأبنية اللغة، وهو حين يفعل ذلك إنما يلجأ إلى عـزل الأبنية من سياق الاستعمال، ويضعها في إطار التعميم والتجريد أما تعليم النحو فشيء آخر نشأ عنه علم أشرنا إليه باسم النحو التعليمي (pedagogical grammar)، وهـو يأخذ من الوصف الذي توصل إليه علم النحو، لكنه لا يأخذه كما هو إنما يطوعه لأغراض التعليم، ويخضعه لمعايير أخرى تستعين بعلم اللغة النفسي في السلوك اللغوي عند الفرد وبعلم اللغة الاجتماعي في الاتصال اللغوي وبعلوم التربية في نظريات التعلم وإجراءات التعليم، وكل ذلك كان غائبا عن محاولات الإصلاح والتيسير، ومن ثم لم تـؤد هذه المحاولات إلى تغيير في المستوى العام لتعليم العربية اللهم إلا إثارة بعض البلبلة.«4 وعلى هذا النهج سار عـز الدين مجـدوب في مؤلفه" المنوال النحوي العربي قراءة لسانية جديدة"، حيث أكد فشل مختلف المحاولات الداعية إلى تيسير النحو، بحجة أن أصحابها انطلقوا من منطلقات قاصرة تخلو من العمق ، فهو يرى أنه وبعـد تحليل كثير من المحاولات التي طارت شهـرتها في الوطن العربي تبين لنا فشلها لأن أصحابها انطلقوا في قـراءاتهم النـقـدية للتراث من منطلقات قاصرة ، تـنم عن غياب تصور واضح للعلم، وما تقتضيه التطبيقات التربوية مـن مبادئ أساسية في صناعة التعليم ، إذ تحولت خاصية الوضوح والبساطة والسهولة إلى مقاييس يعتمد عليها في تقييم التراث النحوي، وأصبح في نظر بعضهم كل أصل من أصول النحو أو مسألة من مسائله، أو باب من أبوابه لا يفيد مباشرة في التعليم تـرفا لا فـائدة منه ولغـوا ينبغي تجنبه، واقتنع الجميع أن نظام العوامل هو المسؤول عن ذلك وافترضوا أن ما عاب به اللسانيون الغربيون تراثهم اللغوي (الإغـريقي والروماني) ينسحب انسحابا كليا على النحو العربي الأصيل، وكانت حاجة اللغة العربية في زعمهم إلى منهج وصفي تماثل حاجة الأنحاء الأوربية القديمة. 5 وختاما لهذه الورقة البحثية يمكن القول أن النحو العربي ليس علما صرفا قائما على قواعد جامدة، أو قوالب ساكنة لا تقبل التغيير، ولا نحوا تعليميا محضا، فهو يتسع لهما معا كونهما متعاضدين متكاملين لاسيما إذا عـلمنا أنه لا تعارض في حضور الغاية العلمية إلى جانب الغاية التعليمية، فالنحاة احتاجوا إلى وسيلة تحفظ لغتهم من اللحن، فتوصلوا إلى علم قائم بذاته له أصوله ومناهجه، فهم وإن كانوا يقصدون تـلقين الفصاحة، ووضع حد للحن فإنهم وجدوا أنفسهم يكشفون أسرار اللغة العربية، ويفسرون حقائقها بطريقة علمية ، كما ينبغي إدراك أن النحو جهاز كامل ومتكامل ، وأن أي حـذف اعتباطي غير مدروس لأية نظرية من نظرياته، أو باب من أبوابه سيؤدي لا محالة إلى إفساده والإخلال به، ذلك أن أزمـة النحو لا تكمن في حقيقة الأمر في النحو في حد ذاته كعلم يسعى إلى وصف أبنية اللغة واستنباط القواعد معزولة عن سياق الاستعمال وإنما تكمن في: 1-عدم الإلمام بجوانب إشكالية اللغة العربية؛ حيث يقتصر تناولها عند الكثير من الدارسين على الجوانب التعليمية والمصطلحية دون الخوض في دراسة علاقتها بالدين والسياسة والوطنية والقومية، ذلك أنها تمثل مقـوما من أهـم مقـومات كيان الأمة ، فهي الحاملة للثـقافـة والمكون لبنية التفكير. 2-سوء التشخيص لطبيعة الداء اللغوي، إذ يوجه بعض الباحثين سهامهم إلى اللغة العربية ويتهمونها بتهم عدة منها أنها تحمل بداخلها كوامن التخلف الفكري والعجز عن مواكبة مستجدات العصر. 3-الانبهار بثقافة الغـرب ولغاته، وتدهور الاهتمام باللغة العربية واعتزاز بها، تحت تأثر بعض المثقفين بتلك بالصيحات الداعية تارة إلى تفضيل اللغات الأجنبية، وتارة أخرى بتصديق إدعاء صعوبة النحو العربي، بالرغم من الحقيقة العلمية التي أجمع عليها الباحثون هي أن التعليم بغير اللغة الأم يغلق مفاتيح الفكر، ويعوق عملية الإبداع والابتكار لدى المتعلمين . 4-غياب الإرادة الحقيقة للإصلاح اللغوي ، فالمناهج المدرسية في مختلف البلاد العربية تتجاهل الآليات والطرق الحديثة في التخطيط والانتقاء والعرض والترسيخ ، التي يمكن أن تستغل لأغراض تعليمية من شأنها أن تفـيد متعلمي اللغة العربية، ولا تسند صناعتها وإعداد محتوياتها وصناعة الطرائق التعليمية إلى ذوي الاختصاص، ممن تسلحوا بالمعارف الحديثة في مجال العلوم اللسانية وتعليمية اللغات والأدبية . - الإحالات والمراجع : 1-عبده الراحجي، دروس في المذاهب النحوية ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية بيروت لبنان،1988م، الصفحة171 2-المرجع نفسه ، الصفحة172 3-المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4-عبده الراحجي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية بيروت لبنان، 2004م، الصفحة103 5-عز الدين مجدوب، المنوال النحوي العربي، قراءة لسانية جديدة، الطبعة الأولى، دار محمد علي الحامي تونس،الصفحة48 بتصرف
25.07.2017
تقرير عن أعمال الندوة الدولية "المنحى الوظيفي في اللسانيات العربية وآفاقه": تغطية إدريس عمراني
من أين يمتح الاتجاه الوظيفي أسئلته، وبم تغتني موضوعاته وكيف يستشرف آفاقه؟ ما هو حضور هذا المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي القديم؟ ما هي حدود التقاطع بين الطرح الوظيفي المعاصر وطرح ابن جني فيما يخص البعد التواصلي عامة وإدماج مكونات اللغة في قصودها الدلالية والتداولية خاصة؟ كيف تتحقق وظيفية النحو العربي؟ هل هناك خصوصيات لكل من المتكلم والمتلقي في الخطاب عند القدماء في ضوء اللسانيات الحديثة؟ ما هي أوجه التعالق القائمة بين نموذج مستعملي اللغة الطبيعية ونحو الخطاب الوظيفي؟ في مدار هذه الأسئلة ونظيراتها، نظم مختبر البحث اللساني والبيداغوجي برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس يومي الجمعة والسبت 23 و 24 نونبر 2007 ندوة دولية بعنوان"المنحى الوظيفي في اللسانيات العربية وآفاقه" وقام بتنسيق أعمالها الدكتور عز الدين البوشيخي. وقد اتسمت جل العروض والمداخلات المقدمة بالتنوع والإكتناز من حيث الطرح والصياغة. وعلى الرغم من كثرة هذه العروض (عربية وفرنسية)، وتداخل محاورها، إلا أنها لم تخل من لحظات الاستمتاع المعرفي الذي طبع بعضها من خلال تدخلات بعض الباحثين التي أبانت عن قدرات تعبيرية وكفاءات إبداعية تؤكد بالملموس على وجود جيل جديد يتأهب لخوض مجازفة الإبداع بمنتهى الرسوخ والطمأنينة، علاوة على حضور أسماء وازنة من مثل البروفسور لاشلن ماكنيزي والدكتور أحمد المتوكل وغيرهما...مما أضفى على أجواء هذه الندوة مسحة علمية متميزة في سياق إشكالي يدعو إلى طرح مجمل الأسئلة الوظيفية المفضية إلى عتبات التأمل اللساني المنتج والفعال. وفي هذا الإطار، تم افتتاح أشغال هذه الندوة بكلمة لرئيس جامعة مولاي إسماعيل ألقاها عنه نيابة الدكتور عبد المجيد حجي أبرز فيها أهمية هذا الملتقى العلمي في ثلاث نقاط محورية: أولها تتجلى في اعتبار اللسانيات حقلا من الحقول المهمة، وثانيها تتمثل في أن مسألة الهوية لها علاقة وطيدة باللغة، وثالثها صاغه في تمن يود من خلاله خروج اللسانيين المغاربة إلى العراء للحديث عن المسألة اللغوية، ودراسة تداخل الألسن حتى لا يترك المجال للأشباح. وفي هذا السياق شكلت هذه الندوة محطة بارزة لترسيخ هذه الأفكار والتوجهات. من جهته ذكر نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عز الدين السلاوي بسببين رئيسيين من أسباب تميز هذا الملتقى لخصهما فيما يلي: 1-العمل الدؤوب لشعبة اللغة العربية وآدابها على تنظيم لقاءات علمية بشكل متواتر. 2- حضور وجوه بارزة من المختصين والمهتمين لتدارس المنحى الوظيفي وتعميق البحث فيه واعتباره قيمة مضافة للمؤسسة بوجه خاص. وأبان في معرض تدخله أن الإرادة الراسخة لهذا الملتقى جسدتها أبعاد ثلاثة تمثلت في إرساء القواعد ومواكبة التطورات وإحداث التغيير. وبنفس صادق وتلقائية مؤثرة، جاءت كلمة الدكتورعز الدين البوشيخي باسم اللجنة المنظمة لتزكي كل الطروحات السابقة، وتؤكد أن استضافة هذه الندوة العلمية كان لاعتبارات عديدة أبرزها: - أن الموضوع الذي اختارته للتداول والنقاش" المنحى الوظيفي في اللسانيات العربية وأفاقه" موضوع مترسخ في فكرنا اللغوي العربي القديم والحديث. - أن اللسانيات الوظيفية كما أنتجت في الغرب أحدث عليها اللسانيون المغاربة تعديلات مهمة، مست إطارها النظري وقواعدها ومبادئها. - أن التطور في هذا الموضوع ما زال متابعا ومستمرا باستضافة رائد من رواد هذه اللسانيات الوظيفية لاشلن ماكيزي الذي يطور نظرية "نحو الخطاب الوظيفي" في كتاب ينوي إصداره سنة 2008، وهذا في حد ذاته مكسب جديد نفتخر به ونعتز. - الاعتياد على تنظيم لقاءات ذات طابع عام بمناهجها وإسقاطاتها، والأن نلج تجربة جديدة في نظرية من النظريات اللسانية بعقد مائدة مستديرة تتناول تفاصيل هذه النظرية. ووفق هذا التأسيس النظري يمكن أن نؤطر كل مداخلات المشاركين في محورين عريضين: أولا: رؤى وظيفية في الفكر اللغوي العربي القديم: " الفكر اللغوي العربي فكر وظيفي بامتياز" بهذا الاستخلاص النظري المثير انعقدت صبيحة يوم الجمعة الجلسة الأولى برئاسة الدكتورة نعيمة الزهري التي ذكرت بعدد من القضايا تستدعي جانبا من التأمل والتفكير كان أهمها: -النظر إلى الفكر اللغوي العربي القديم باعتباره كلا غير قابل للتجزيء (أصول، تفسير بلاغة، نحو). - عدم التعامل مع هذا الفكر على أساس ثنائية، قديم/حديث – بل هناك فرق في درجة الاقتراب من بعضها البعض على الرغم من تباعد الأزمنة والأمكنة. - عد الدكتور أحمد المتوكل مبدع ومنظر منهجية الفكر اللغوي العربي القديم ومطورها. انطلاقا من هذه الخلاصات المنمدجة، ألقى الدكتور بنعيسى أزاييط عرضه حول "ملامح من النظرية الوظيفية عند ابن جني القدرة التواصلية نموذجا" سعى من خلاله للوقوف عند محطات أربع أجملها فيما يلي: -أولها: عده مقدمة منهجية كان عبارة عن احتراسات أبرز فيها بأنه لابد من التسليم بجملة من الأمور – يجب مراعاتها- عند محاولتنا عقد مقارنة بين طرح ابن جني والطرح الوظيفي المعاصر، وهي: - أن مقاربة بن جني لا تتيح إمكان التعميم المفاهيمي إلا بما تسمح به المقاربة في بعدها المعرفي، وإلا طبع هذا العمل نوع من التعسف في طريقة التعاطي معه. -الاحتراس الثاني قائم على أن فهم بنية التواصل اللغوي ينبغي أن تؤسس على معطيات بنيوية وحضارية منظورا إليها من خلال المحاقلة المعرفية. - ضرورة النظر إلى اللغة أو الخطاب على أنه شبكة من العلاقات البنيوية والميتابنيوية (تركيب، صرف، صواتة...) وغير الملموس أصلا من حيث الدلالة والمعنى...وما يحكمه من معطيات سياقية وحضارية. ومن تم فالغاية التواصلية والنظر الوظيفي القصدي وارد عند بن جني، وبالتالي فمستويات الخطاب دائما ترد إلى مستوى واحد أو لطبقة واحدة كالرقم تضعه على المرقوم أو الميسم على الموسوم. -الاحتراس الرابع يتجلى في الهدف، بحيث إن المأمول هو أن يفهم من هذا الاقتراح على أنه نوع من المقاربة في صلب المواضعة الوظيفية. وعليه، فإن هذا العرض ينصب في عمومياته على ذلك الإدراك الشامل للغة من حيث كونها لغة تتميز فيها خصائص الحكمة وعلائق الاتقان، واعتبارها- في هذا الشأن- لغة اتقان لأن حدها هي" أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"، فالغاية من اتقانها هو التواصل السليم والتعبير عن أغراض متكلميها في حياتهم ومعاشهم وثقافتهم. بهذه المعطيات الموضوعية والاحتراسات المنهجية يتحدد الإطار النظري للنظرية الوظيفية عند بن جني. - ثانيها: يزعم فيه الباحث أن النظرية التواصلية العامة عند بن جني تقوم على المعالم الآتية: 1-العناصر الثابتة: ومنها قواعد المكون النحوي الشامل للغة الذي يحتوي على الأصناف التالية: (قواعد تركيبية، قواعد التوليف الصوتي وتصريف اللفظ، وقواعد المواضعة المعجمية أوالدلالية السائدة في كلام العرب اطرادا أو شذوذا...) وتمكن هذه القواعد من إيجاد أسس ثابتة تشكل معطيات قابلة للحوسبة المعاصرة وتترجم الملكة اللسانية التي يتوفر عليها المتكلم العربي في ثابت اللغة ومتغير الخطاب. 2-المبادئ المتغيرة: كونها متغيرة لأنها مرتبطة بالخطاب المقامي وطبقاته التبليغية والبلاغية، ومنها أولا مبدأ الإيجاز بحيث إن المتكلم العربي يراعي حيثيات الخطاب انسجاما مع أن" لكل مقام مقال"، غير أن بن جني يلاحظ أن العرب إلى الإيجاز أميل، وعن الإكثار والإطناب أبعد وهذا هو الطابع الجواني للخطاب. وهناك ثانيا مبدأ مشاهدة الأحوال وهو وارد عند بن جني بتحليله الأثر اللغوي للأحداث على خلفية أن الخطاب اللغوي هو حمال لعدة معاني استنادا لمقولة" رب إشارة أبلغ من لفظ"، أو بتعبير بن جني" أنا لا أحبد أن أكلم أحدا في الظلمة" ويبدو أن معظم العلماء لم يوسعوا في هذا البعد الإشاري للمعاينة، ويندرج ضمن هذا المبدأ، مبدأ "شهادة الحال" في قولنا للقادم من سفر" خير مقدم" كما أن الدلالة المصاحبة لها دور فعال ومباشر في استخلاص المعاني والحركات (تقطيب الحاجبين مثلا)، وأدرج مبدأ ثالثا سماه"مبدأ تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان" مشيرا إلى تنبه الفكر اللغوي لهذا الأمر على يد الدلاليين والتداوليين والمناطقة(Recanati مثلا)، وأردف كلامه بالحديث عن مبدأ "أكثر اللغة مع تأمله مجازا لا حقيقة"، أبان فيه أن بن جني حاول أن يؤسس نظرا تداوليا جديدا إزاء المستويات اللغوية( نحوا ودلالة وتداولا) في قوله:"إن أغلب اللغة مجازا" وذلك في الغاية التي تجمع بينها عندما تغدو اللغة مستوى واحدا في الممارسة والإنجاز الفعليين. - ثالثها: حاول من خلاله الباحث استخلاص بعض وجوه التقاطع بين الطرح الوظيفي المعاصر وطرح ابن جني فيما يخص البعد التواصلي عامة وإدماج مكونات اللغة في قصودها الدلالية والتداولية خاصة بناء على مستويين اثنين: على مستوى النظر الوظيفي عند سيمون ديك، وكذا على مستوى المرامي والأبعاد والمكونات، وهنا أحال على كل مؤلفات الدكتور أحمد المتوكل التي تتمتع بهذا النوع من التحليل بتركيزها على وظيفية اللغة. رابعها: أفرده بشكل خاص لتحديد كيفية تحديث آليات بن جني الوصفية الوظيفية في ضوء معطيات التناول الوظيفي المعاصر انطلاقا من الإرتكاز على الثوابت والمتغيرات الواردة عنده لخدمة اللغة العربية وخطابها، محاولا في الإتجاه ذاته توضيح هذه الوصفية (صرفية كانت أو تركيبية أو نحوية). ودمجها في المرتكزات الوظيفية (دلالية وتداولية ومقولاتية) بغرض استخلاص بعض ملامح النظرية التواصلية عند بن جني. ومن أجل إبراز خصوصية الدرس اللغوي العربي القديم ألقى الدكتور عبد العزيز العماري عرضا اختار له عنوان "أفكار وظيفية في التراث اللغوي العربي" أشار فيه إلى أن هذا التراث وظف أفكارا وظيفية في وصف الظواهر اللغوية وتفسيرها معتمدا في تحقيق ذلك على أدوات لسانية ذات طبيعة وظيفية، وشدد في هذا الإتجاه على أن قراءة متعمقة للتراث والتأمل في دراسته، تكشف لنا أن النحاة والبلاغيين والأصوليين كانوا واعين بضرورة تحديد وظائف الجملة الأساسية من خلال حرصهم على تحديد مكوناتها (فعل/فاعل، مبتدأ/خبر)، موظفين لمصطلحات خرى، كالإسناد، والتعليق، متتبعين للمنهجية التي سلكها النحو العربي القديم الموجود في المنطق والأصول والبلاغة وغيرها، وحتى يكون الباحث موضوعيا في تناوله، عمد إلى تبيان هذه القضايا انطلاقا من المسلمات التالية: - وظيفة الفعل: كل النحاة يؤكدون أن الفعل أقوى العناصر في الجملة، وله وظيفة خاصة تختلف شيئا ما عن وظيفة، المكونات الأخرى، وهو مؤهل للقيام بوظيفة التعليق (وظيفة الانتقاء التركيبي المجرد مثلا) - وظائف متعلقات الفعل: تتمثل في أن وظيفة الفاعل هي الفاعلية ووظيفة المفعول هي المفعولية، بحيث إنهم لم يستعملوا مصطلح "وظيفة" وإنما استعملوا مصطلح " المعنى"، وأن الوظائف تركيبية كانت أو دلالية لا تختلف عن المنظور التقليدي في تحليلهم لها. في حين نجد أن الدكتور أحمد المتوكل قدم هذا النحو بمنهج وظيفي، لكن الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري اعتمد في تحليله له على منهج توليدي صرف (الوظائف لا تختلف عن الأدوار). وجدير ذكره أن المبتدأ يطرح إشكالا تركيبيا ودلاليا، بينما وظيفة الخبر تشبه الفعل، مذكرا أن بعض اللغويين العرب اهتموا بتحديد الوظيفة الأساسية للغة وهي"التعبير عن الأغراض والأحاسيس" إلى أن توصل أخيرا لأمر أن اللسانيات بشكل عام لم تبدأ من فراغ وإنما جاءت على أنقاض الفكر اللغوي العربي. كما سارت مداخلة الدكتورعبد النبي الذكير في اتجاه مقاربة"وظيفية النحو العربي نحو العلامة نموذجا" في إطار حدود وظيفية قائمة ومشروعة للنحو العربي، ومن تم يفترض أن هناك توجهين اثنين يجب بحثهما: الأول نظري تصوري مسلكه التحقق من معنى الوظيفية في التراث النحوي، والثاني عملي مراسي القصد منه التثبت من هذه القضية بالشاهد والمثال. وفي ثنايا مداخلته أكد أن هذه الوظيفية في التراث العربي هي واضحة وجلية من عدة نواح أجملها في الغاية من النحو عند أئمة أعلام كابن جني وابن الطراوة وابن المستوفي وغيرهم حسب تعريفاتهم له، وكذا في تعدد هذا النحو وأنماط خطابه، باعتبار أن هذا النحو هو لدى الحذاق أنحاء: نحو للمبتدئ وآخر للشادي وثالث للمنتهي، موضحا أن المتأمل في هذا النحو يجد في معظم أبوابه وفصوله ومباحثه سيادة المعاني الوظيفية، لأن الغاية من النحو مقاصد مقصودة والمخاطب يشهد وظيفة معهودة، وقد أنهى الباحث حديثه بالتذكير أن علامات وظيفية النحو العربي كثيرة ومتعددة ناهزت السبعين علامة أو تزيد، ومثل لذلك بالسين وسوف ولن ولعل وليت... ثانيا: خصوصيات اللسانيات الحديثة: إضاءات وظيفية: في إطار التعالق المعرفي بين النحو العربي القديم والأنحاء المعاصرة، عقدت جلسة مسائية ثانية برئاسة الدكتور يحي بعيطيش افتتحها الأستاذ عمر مهديوي بمداخلة تمحورت حول" الإحالة بين المنطق والفلسفة واللسانيات"، أكد فيها أن موضوع الإحالة أو المرجعية من المواضيع التي شغلت بال المناطقة بوجه خاص (فريدج، راسل...)، وما قدمه العرب عامة يشكل نقطة تستحق العناية والإهتمام والتأمل، وانتقل إلى فحص هذه المسألة انطلاقا من قضايا ثلاث: بحث أولها قضية الإحالة والمنطق ممثلا لذلك باسم العلم واختلاف المناطقة في تصنيفه هل هو من النماذج الدلالية أو التداولية. ثم تساءل : ما وظيفة اسم العلم؟ وما دلالته؟ وهل يحيل على مرجع؟ بينما ركز في ثانيها على العلاقة بين الإحالة والفلسفة مستعرضا لخاصيات فلسفية ثلاث حددها راسل وهي: الخاصية الدلالية (ممثلة بالسور الوجودي) والخاصية الإسمية (الموجودات العينية) والخاصية الواقعية (وقصد بها الموضوعات الفيزيائية)، واقتصر في آخر قضية للتدليل على العلاقة التي تجمع بين الإحالة واللسانيات والإشكالات التي تثيرها في هذا النطاق مستخلصا بعض الإشراقات اللغوية في فكرنا اللغوي العربي القديم. أما البحث الجاد الذي قدمته الدكتورة نعيمة الزهري في موضوع "الوصف الأدبي في نحو الخطاب الوظيفي" فقد استشرفت فيه بلوغ هدفين اثنين: 1 ـ رصد الخصائص التداولية والخصائص التركيبية والصرفية والتطريزية لنص وصفي فني. 2 ـ وصف هاتين الفئتين من الخصائص في إطار نحو الخطاب الوظيفي وعلى ضوء مفهوم التغليب كما ورد عند الدكتور المتوكل (المتوكل 2003). في ظل هذا التحديد، صرحت أن لا أحد يجادل أن نظرية النحو الوظيفي قد حققت من النصج النظري ما يكفي، فكان لزاما تثمين هذه الخطوة بتطبيق عملي وهو ما دعاه المتوكل (المتوكل 2006) ب "الكفاية الإجرائية"، لذلك يعد إقحام مجال النص في الدرس اللساني الحديث رائز من روائز المفاضلة بين عدد من الخطابات سواء منها الإقناعية أو الحوارية أو الحجاجية أو القانونية أو غيرها.. معرفة للنص الأدبي بكونه "كل فعل تلفظي مجسد لرؤية خاصة بالأديب تنتظم مكوناته وأنماطه ضمن نسق تعبيري معين"، في هذا الإطار عمدت إلى تنميط النصوص في النحو الوظيفي تنميطا بنيويا بقوالبه وأساليبه وبنياته. ولتأدية هذا الغرض قامت بانتقاء نصين متكاملين، الأول أدبي تحت عنوان ( في عرض البحر)، والثاني علمي موسوم ب (البحار والمحيطات) إلا أن النص الأدبي تتخلله سمتان أساسيتان هما: حضور المتكلم فيه حضورا متميزا وصريحا علاوة على الصور البلاغية (الإستعارة والمجاز وغيرهما) الطاغية على النصوص الموغلة في الفنية، ويتجسد الهدف في الاقتصار على السمة الأولى، وإرجاع السمة الثانية بإضافة قالب إبداعي تكمن مهمته في رصد الملكة الإبداعية التي تسهم في إنتاج الخطاب الإبداعي، مع التذكير بالإطار النظري المعتمد وهو نحو الخطاب الوظيفي في صيغة نحو قالبي طبقي كما هو عند الدكتور المتوكل (المتوكل 2003) بمستوياته وطبقاته. لكن هذه الهيكلة يقول عنها هنخفلد بأنها يخلفها محوران: محورسلمي ومحور علاقي يهم التعالقات الحاصلة بين طبقات المستوى الواحد، في هذا الصدد أردف المتوكل قائلا بأن توالي الطبقات أيل لقيود خطية وقيود سلمية تحكم تحديد مستوى معين لعناصر المستوى الذي يسلكه. ومن الملاحظات التي سجلتها في مختتم إحاطتها، أن نحو الخطاب الوظيفي برهن على نجاعته في وصف النصوص العادية أو الفنية وأتاح من الإمكانات ما لا تتيحه الأنحاء التقليدية، مستوثقة من أمر أن اللسانيات –وخاصة الوظيفية منها ـ وما أفادت به من أغراض ومقاصد يمكن أن تفي به فروع أخرى كالشعرية والنقد الأدبي وتحليل الخطاب. وبمداخلة جمع فيها بين فكره الإبداعي وتخصصه المعرفي الأكاديمي قدم الدكتور عز الدين البوشيخي عرضا بعنوان "نموذج مستعمل اللغة الطبيعية ونحو الخطاب الوظيفي" استهله بأربع إضاءات منهجية متآسرة، أولاها عد النحو الوظيفي نموذجا نحويا مستقلا، وثانيتها أن هذا النحو هو بمثابة قالب نحوي من داخل نموذج مستعمل اللغة الطبيعية، وثالثها جسده في التعالق الحاصل بين نحو الخطاب الوظيفي ونموذج مستعمل اللغة الطبيعية، ورابعها خصه لإعادة الاعتبار لهذا النموذج بالذات. وعبر تأطير منهجي عام لعرضه أوضح أن النحو الوظيفي منذ ظهوره على يد رائده سيمون ديك كان الهدف منه هو إقامة نموذج نحوي يرصد خصائص الخطاب الطبيعي عن طريق وصف كيفية استعمال هذا اللسان وتحديد الأهداف التواصلية التي يستعمل من أجلها، ولذلك عني سيمون ديك أيما عناية ببناء النموذج النحوي وتأسيسه على قاعدة تداولية، لكن مع تطور هذا النموذج (ديك 1989) ظهرت نزعة جديدة تمثلت في بيان أنه لا يمكن رصد وتفسير العمليات الذهنية ـ التي يتم بمقتضاها إنتاج اللغة ـ إلا برصد كل المكونات التي تتدخل في هذه العمليات، وفي هذا الإطار دعا سيمون ديك إلى إقامة ما سماه ب "نموذج التفاعل الكلامي" بين المتكلم والمخاطب يتم عبره الإنطلاق من المعلومات التداولية وتحديد مقاصدها وتأويلها، وفي هذا الاتجاه بين الدكتور عز الدين البوشيخي أن ثمة قسمين من المعرفة، معرفة مشتركة ومعرفة غير مشتركة وهي التي لخصها الدكتور المتوكل ضمن مكونات التواصل اللغوي ووسائله وآلياته. فحديثنا عن النحو الوظيفي إذن هو حديث عن القالب النحوي داخل نسق التواصل العام وهو نموذج مستعمل اللغة الطبيعية. في سياق هذه التحولات طرأت على هذا النموذج تعديلات هامة أبرزها: ـ إدراج المتوكل "القالب الشعري" ضمن قوالب هذا النموذج بخلق علاقات بينه وبين باقي القوالب الأخرى ـ التعديل الهام الذي اقترحه البوشيخي (البوشيخي 1998) بتطوير ما سماه المتوكل ب "القالب الشعري" إلى "قالب تخيلي"، مميزا بين أصناف هذه القوالب (قوالب إمداد وقوالب تخزين). ـ مركزية القالب المعرفي في هذا النموذج باعتباره المخزن لكل المعلومات، وبالتالي لا يمكن عده هامشيا أو مساعدا. على إثر هذه التعديلات، انصب النقاش حول بنية النحو الوظيفي وعن العناصر المقصاة منها، ليبقى السؤال المطروح هو: هل يتم وضع القالب التداولي داخل هذه البنية أو إخراجه منها ليصبح مكونا من مكونات اللغة الطبيعية؟ فحوى هذا السؤال بينه المتوكل وهو يتحدث عن كيفية عمل القوالب، بحيث اعتبر القالب التداولي مستقلا عن القالب النحوي، أما نحو الخطاب الوظيفي فأساسه هو الفصل 18 من كتاب ديك (ديك 1997ب)، مبرزا أن النحو الوظيفي هو نحو خطاب لا نحو جملة، وإنما اعتني مرحليا بالجملة، وعني بعد ذلك بالخطاب. وفي ثنايا تحليله أفاد أن الدكتور المتوكل قال بفرضية التماثل البنيوي بين بنية النص وبنية الجملة، وبين المفرد والمركب الإسمي إلى أن توصل للبنية الخطابية النموذج وكل أشكال الخطاب غير اللغوي وتحققاته المختلفة. ففي الأطوار الأولى للنحو الوظيفي أخرجت القوة الإنجازية من القالب النحوي واقترح معالجتها في القالب المنطقي، وفي مرحلة موالية أصبح القالب النحوي قالبا بنيويا صرفا وأصبح كل ما هو تداولي، موزعا بين القالب المنطقي والقالب التداولي. وقد أنهى عرضه بتسطير الخلاصات الآتية: ـ لا توجد دلائل واضحة لدى كل من ماكنزي وهنخفلد يبرران بها اقتراح تقسيم نموذج القالب المعرفي لمكونين اثنين: المكون التصوري والمكون السياقي. ـ إهمال القوالب الأخرى (القالب المنطقي، والاجتماعي، والتخيلي...) داخل نحو الخطاب الوظيفي. ـ يقترح الدكتور البوشيخي إعادة الاعتبار لكل مكونات نموذج مستعمل اللغة الطبيعية، لأنها هي التي ترصد فعليا كل أنماط الخطاب اللغوي وغير اللغوي. في صلب هذا التعدد والثراء، تواصلت أشغال هذا الملتقى بعقد جلسة ثالثة برئاسة الدكتور بنعيسى أزاييط، وكان أول المتدخلين فيها الدكتور أحمد المتوكل الذي أثر أن يقدم باقتضاب مداخلته باللغة الفرنسية، بحيث عرض لتجربته الخاصة في ميدان اللسانيات الوظيفية وتوقف بالتالي عند أبرز محطات المنحى الوظيفي في اللسانيات العربية، مستعرضا لأصول تشكل ونشأة المنحى الوظيفي في المغرب والعالم العربي بشكل عام، وعن الموقع الذي يحتله هذا المنحى في خريطة البحث اللساني، دون أن ينسى أفضال هذا النموذج على النماذج اللسانية الأخرى باقتحامه مجالات ميدانية متشعبة تتمثل في استثمار هذا التوجه في ديداكتيكا اللغات والاضطرابات اللغوية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والترجمة... ومن الموضوعات التي أثرت أشغال هذا اللقاء ولم يلتفت إليها الدرس اللساني، انتقى الدكتور يحي بعيطيش من جامعة قسنطينة بالجزائر بحثا مستخلصا من أطروحته بعنوان "نحو أسلوبية وظيفية للنص الأدبي ـ النص الشعري نموذجا"، رصد من خلاله الخطوط العريضة لمشروع اقترح تسميته بأسلوبية وظيفية، وهي أسلوبية مركبة من تأليفة تمزج بين مبادئ نظرية النحو الوظيفي ممثلة في مبدأ تبعية البنية للوظيفة ومفهوم الملكة التبليغية (Compétence communicative) ومفهوم الملكة البيانية (الشعرية بمصطلح المتوكل) والوظيفة الأسلوبية وآليات تشغيل القوالب، وبين نموذج جاكبسون التبليغي بوظائفه المعروفة وبين النموذج العاملي لغريماس حول النص بصفة عامة والنص السردي الروائي بصفة خاصة. وبناء عليه قدم الباحث ومضات حول الجانب النظري لبحثه عرض فيه لأهم المفاهيم النظرية الإجرائية، محاولا توظيفها في الجانب التطبيقي الذي عمد فيه إلى تحليل نص شعري ممثل في بيت غزلي لأبي الطيب المتنبي اتخذه كعينة استخلص منها مقاربة وظيفية لتحليل أي نص شعري، سواء على مستوى البنية الطبقية القالبية أوالمستوى السيميائي التأويلي. ويقفل الباحث مداخلته بذكر أهم الخطوات المقترحة في المنهجية الوظيفية لتحليل النص الأدبي بصفة عامة والنص الشعري بصفة خاصة. وبمصاحبة الشاشة المشغلة بالحاسوب، قدم الدكتور حفيظ اسماعيلي عرضا لافتا للانتباه، عن الحجاج المغالط ـ مقاربة وظيفية" وهو بالمناسبة عرض مشترك مع الأستاذ محمد أسيداه، رام من خلاله الباحثان الوقوف على وجوه التحاور والتجاور والتكامل الممكنة بين اللسانيات والحجاج باعتبار أن هذا الأخير يرسخ لثقافة الحوار والتواصل التي تقوم على الانتصار لرأي ما والدفاع عنه بالحجة الفعلية وبوسائل الإقناع والإفحام والغلبة بالحجة والدليل، مع التركيز بشكل خاص على الحجاج المغالط الذي يقوم على الالتباس وتخليط المعاني وعلى السبل التمويهية والتغليطية والتضليلية التي تفضي إلى خرق "قواعد الحوار والتواصل" ومقتضيات "المجال التداولي"، كما كشف العرض عن الكيفية التي يمكن أن يسهم بها النحو الوظيفي في فضح المغالطة بإعادة صياغة الحجة صياغة سليمة عن طريق رفع التباسها، ولتفادي هذا الالتباس وظف الباحثان اقتراحات الدكتور أحمد المتوكل في هذا الإطار والتي ترقىـ حسب تعبيرهما ـ إلى طبقة قيود تضمن سلامة تكوين العبارات في المناقشات والمحاورات مما يجعلها تستجيب لضرورة تطوير أنساق منطقية غير صورية تروم الاستجابة لمقومات الخطاب الطبيعي ومقتضياته وضبط شروط تقويم الحجج. وبهذه المعطيات المهمة فقد استشرفا آفاق بحثهما بأسئلة إشكالية معلقة من قبيل: كيف نوظف اللغة في الحجاج؟ وكيف يسخر النحو الوظيفي في دراسة التعالق بين الحجاج كاستراتيجية، وبين اللغة ليس كحمولة فقط بل كبنية؟ وإلى أي حد تسعف آليات النحو الوظيفي في فك الحجاج المغالط؟ ما هو نموذج مستعمل اللغة الطبيعية المحاجج؟ ما هي القوالب التي تشغل في الخطاب الحجاجي؟ وكيف تتعالق وهي تشتغل؟ وكيف يعبر الصرف والتركيب عن المقتضيات التي تأتيه من القالب المنطقي؟ إلى جانب العروض التي قدمت باللغة العربية، ثمة عروض أخرى قدمت بالفرنسية في جلسة أخرى يومه السبت برئاسة الدكتور أحمد المتوكل، ومنها العرض المطول لأحد أعمدة النظرية الوظيفية البروفسور لاشلن ماكينزي (Prof. Dr. Lachlan Mackenzie) الذي بحث فيه تنظيرا وتطبيقا إشكال "الوظائف التداولية بمعالجة الدكتور المتوكل، مراجعة وتقويم في إطار نحو الخطاب الوظيفي" راصدا لمجمل مستجدات نظرية نحو الخطاب الوظيفي في عدد من مستوياتها، مع استقرائه لبعض الظواهر اللغوية وخاصة الوظائف التداولية في اللغة العربية. أما مداخلة الدكتورة أمامة الكتاني فقد تناولت فيها بالدراسة والتحليل موضوعا متميزا اختارت له عنوان: « Vers un modèle de l’analyse communicationnelle intégré » ركزت فيه بالذات على بناء نموذج لساني لتحليل العملية التواصلية في أبعادها المختلفة، مسخرة في هذا الإتجاه نموذج مستعمل اللغة الطبيعية ومكوناته، دون إغفالها المفاهيم النظرية والإجرائية التي يتأسس عليها النموذج الوظيفي. وتلافيا للتجريد والصورنة التي يمكن أن تسقط فيه فضلت الباحثة التوقف عند جدوى هذا النموذج بتطبيقه على تحليل للخطاب السياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية في المغرب لسنة 2002. وفي دراسة جادة له، تقدم الدكتور محمد جدير بعرض عنونه « Focus et dimension textuelle, le cas du roman policier » ، انصب اهتمامه فيها بالخصوص على تحليل مقاطع من رواية بوليسية "ضحايا الفجر" لميلودي حمدوشي واتخاذها متنا لعمله. ولإضاءة هذا النص الروائي المعالج، عمد الأستاذ الباحث إلى توظيف بعض آليات نظرية النحو الوظيفي وما يمكن أن تمده به ـ في هذا الصدد ـ من إواليات تركيبية ودلالية وتداولية وخطابية. وحتى يختبر إجرائية المفاهيم الوظيفية الموظفة في هذا التحليل، قام بمعالجة أسماء الاستفهام (من، متى، كيف) والأداتين (هل والهمزة) في أبعادها الخطابية، ثم علاقة هذه الأسماء والأدوات بحيز التبئير (المكون ـ الحمل) مع العمل على تفسير أنماط الوظيفة التداولية البؤرة (بؤرة الجديد، بؤرة المقابلة) وتحققاتها المختلفة. ورغبة من منسق أعمال هذا الملتقى الدكتور عز الدين البوشيخي، واللجنة المنظمة المرافقة له في تنويع المشاركة وإضفاء طابع الحميمية على هذا اللقاء، فقد توجت نشاطات هذه الندوة بمائدة مستديرة عقدت بفندق باب منصور بحمرية، استضافت فيها رواد هذه النظرية وبعض الباحثين المتخصصين والمهتمين لعرض المستجد من نظرية نحو الخطاب الوظيفي لصاحبيه هنخفلد وماكينزي (Hengeveld, Kees or J. Lachlan Mackenzie (2006)) ومناقشة تطبيقاته وآفاق تطويره. وقد تعاقب فيها على الكلمة الأستاذان أحمد المتوكل وماكينزي، بحيث تحدث الأول عن المستوى العلاقي وصلته بالمستوى الصرف التركيبي في نحو الخطاب الوظيفي، مبرزا أن المكون الصرفي في هذا النحو يتخذ وضعا خاصا غير الوضع الذي كان يحتله في النماذج الوظيفية السابقة، إذ يربط هذا المكون ربطا مباشرا بالمستوى العلاقي دون العبور من المستوى التمثيلي. على اعتبار أن الصرف في اللغة العربية مؤهل للقيام بدوري تحقيق السمات التمثيلية (الجهة، الزمن، الوجه، الوظائف) وتحقيق السمات العلاقية (الوظائف التداولية والقوى الإنجازية) وبخاصة الطبيعة التواصلية لوحدات الخطاب والعلاقات القائمة بينها، مستهدفا في السياق ذاته الوقوف على الدور العلاقي الذي يقوم به المكون الصرفي في اللغة العربية مع التركيز على الوجه Modality والإعراب والصلة. أما كلمة البروفسور ماكينزي فقد تحدث فيها عن أهداف ومرامي نحو الخطاب الوظيفي مدققا في كل مكوناته وطريقة اشتغاله. وقد تخلل هذه الجلسة نقاش علمي معمق وصريح بين الدكاترة والباحثين المشاركين والذي استمر لساعات طويلة، انتهى بتسطير خلاصات مهمة ومفيدة لا شك أنها ستدفع بقاطرة النظرية الوظيفية إلى الأمام. في ظل هذا التنوع الذي اكتنف أشغال هذا الملتقى، تكون ندوة "المنحى الوظيفي في اللسانيات العربية وآفاقه" قد اغتنت لا من حيث التنظيم الجيد والحضور البارز لبعض الرواد أو المطارحات اللسانية العميقة التي جسدتها. لذلك فإن نشر هذه العروض سيفتح عيون الباحثين والمهتمين على حقول وزوايا النظرية الوظيفية ومستجداتها، وهذا ـ دون شك كان الهدف الأساسي والجوهري الذي نظمت من أجله هذه الندوة.
29.05.2017
الخطاب الإشهاري من الترويج إلى صناعة الثقافة … عادل بوديار
تمهيد: ظهر الإشهار نتيجة الحاجة إلى ترويج السلع، وهو يمثل الإشهار أحد الأنماط التواصلية الأساسية لترويج السلع عبر الوسائط الإعلامية المكتوبة، والمسموعة، والمرئية بأسلوب إعلاني ساخر ومثير قصد استمالة المستهلك وإغرائه بلغة تجارية بسيطة، وموجزة، ودالة؛ لذلك فإنّ الإشهاري يتصل بالحياة الإنسانية بشكل مباشر من خلال تأسيسه لقيم اجتماعية، وأخلاقية، وحضارية، وتجارية.. فهو يخفي في ممارسته اللغوية والثقافية قيمة ثقافية ذات سمة إيديولوجية غالبة تحاول أن ترسخ لدى المتلقين. 1. تعريف الإشهار: الإشهار هو ذلك الجزء الهام من نظام الإنتاج والتوزيع الجماهيري الذي يترجم في شكل إعلام وتذكير بالسلع والخدمات التي يتضمنها السوق ، فهو وسيلة غير شخصية لتقديم الأفكار والمنتجات والخدمات وترويجها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع ، والإشهار يمثل أحد الأنماط التواصلية الأساسية لترويج البضائع والسلع عبر الوسائط الإعلامية الشفوية أو المكتوبة أو المرئية، الثابتة أو المتحركة، بأسلوب مباشر وصريح يتجه فيه المعلن (المشهر) بإعلانه نحو الزبون بأسلوب غير صريح قصد الاستمالة والإغراء العاطفي، أو هو مجموع الأساليب الاتصالية التي تختص بإعلام الجمهور من خلال وسيلة عامة عن منتح أو خدمة ما ودفع الجمهور إلى اقتناء السلعة المعلن عنها ؛ أنه « هو لغة تجارية: إنه سيناريو تركيبي مفتوح على التأويل الدرامي، أو هو الدعوة إلى الإسقاط وتحريف الدور والبؤرة التي تحقق فيها الأحلام والرغبات. وبهذا فهو استهامي عمومي، كوميديا ورغبة يجب أن تتحقق. فمن خلال فضائل الشراء يمكن لكل شخص أن يجد انعكاسه ممثلا. حينها سيبث الفرد في المنتج من خلال الربط بين الدوال الاقتصادية (المنتجات) والمدلولات الإشهارية (الصور) قيمة ثقافية. فلكل استهلاك يستوعب المحور اقتصاد/إشهار – باعتباره ثقافة » . إن الإشهار عملية اتصالية كاملة تتحقق فيها عناصر الاتصال: * المرسل: أي القائم بالإشهار (المنتج أو الموزع). * الرسالة: الصيغة التمثيلية والترويجية للفكرة المعلن عنها. * الوسيلة : كل وسائل الاتصال الجماهيرية بما في ذلك المسرح، والسينما، والملصقات * المستقبل: الجمهور المستهدف والذي يحدد بناء على معيارين أساسيين: طبيعة المضمون الإشهاري وطبيعة البيئة الثقافية لهذا الجمهور. * الأثر: ونحدده بقياس معدل بثبات أو تغيير السلوك الشرائي بعد التعرض للرسالة الإشهارية أي قياس فعالية الإشهار. 2 ـ الخطاب الإشهاري: يتصل الخطاب الإشهاري بالحياة الإنسانية بشكل مباشر من خلال تأسيسه لقيمتين. الأولى: اجتماعية، وأخلاقية، وحضارية ، والثانية: هي القيمة التجارية المباشرة، فهو يخفي في ممارسته اللغوية والثقافية قيمة ثقافية ذات سمة إيديولوجية غالبة تحاول أن ترسخ لدى المستقبلين (المتلقين)، ونظرا لهذه الطبيعة المتشابكة للخطاب الإشهاري فإنه لا بد أن نميز بيِّن ما هو من الخطاب نفسه بوصفه نسيجا لغويا دالاً يهدف إلى الإقناع ، وبيْن ما هو خارج الخطاب اللساني فيما يتصل من قيم سوسيو اقتصادية. ويتأسس الخطاب الإشهاري في بعده التأثيري على مبدأ الترويج للسلعة، والفكرة المنوطة بها من خلال عرض خصائصها المميزة بهدف دفع الجمهور المستهلك إلى اقتناء المنتوج، ولما كان الخطاب الإشهاري يجمع نسقين دلاليين: نسق لساني، ونسق أيقوني بصري، فإنه العملية الإشهارية تجسد كفعل اقتصادي اجتماعي وفق العلاقة التالية : الإشهار (PUBLICISTE) المستهلك (CONSOMMATEUR) المنتوج (الموضوع) (PRODUIT) ويمكن التمييز بين نسقين في بنية الخطاب الإشهاري، أحدهما لساني يتمثل في العلامة اللسانية، وثانيها أيقوني يتمثل في العلامة البصرية أداته الرئيسية في عالم الواقع، وحضورهما معًا بهيمنة طرف على آخر مبني على قصد معين يتوافق مع المقام الإشهاري. ومن عليه فإنّ الحديث عن الخطاب الإشهاري يفرض التميز بين قطبين أساسيين متباينين ومتكاملين في الآن نفسه، هما البعد السوسيو- اقتصادي الذي يوجد خارج الخطاب، والبعد الخطابي بصفته نسيجا تتشابك فيه مجموعة من العلامات وفق قواعد تركيبية ودلالية، فالمسار السوسيو- اقتصادي يمثل الإطار العام الذي تمارس داخله عملية الإشهار، ويعطي الخطاب الإشهاري لنفسه كمهمة الإخبار عن خصائص ومميزات هذا المنتوج أو ذاك بهدف الدفع بالمتلقي إلى القيام بفعل الشراء. هذه الوظيفة الموضوعية تبقى وظيفته المبدئية، وتتحكم في تكوين المسار السوسيو-اقتصادي العناصر الثلاثة (الإشهار، المستهلك، والمنتوج). أما الثانية: فهو مستوى الخطاب الذي يفترض وجود قائل ينجز مجموعة أقوال ومتلقي يستقبل أساسا خطابًا له مجموعة من المكونات والخصائص التي تجعل منه قارئا ومؤولاً لهذا الخطاب. 3. الصورة الإشهارية: ظهرت الصورة الإشهارية مع تطور وسائل البث والإعلان ورقيا ورقميا، فمثلت أنموذجا للإعلام الاستهلاكي الذي يوظف الوسائل السمعية والبصرية استجابة لمستلزمات اقتصاد السوق الذي يعتمد على الفلاحة والصناعة والتجارة، وعرض السلع والبضائع والخدمات إنتاجا وتسويقا وترويجا، وبذلك فإن العلامة الإشهارية في الخطاب الإشهاري الصورة بمكوناتها المختلفة من صوت، ولون، وحركة، وموسيقى، وديكور، وهي جميعها تمثل علامات سيميائية تهدف (( إلى إعادة صياغة المعنى اللساني المثبت باللفظ، وإضفاء الحياة والدينامية عليه فيضحي حركة مشهدية نامية، ولعل أهم الوظائف التبليغية التي تحققها الصورة أنها تخرج القيم المجردة من حيز الكمون إلى حيز التجلي فتصبح واقعا ماديا محسوسا في ضوء ما ينتج من مشاهد إشهارية تتخلل أو توازي الخطاب اللساني، وربما حولت الصورة العوالم المجردة والمثالية إلى عوالم ممكنة إن القيمة الإقناعية للصورة في الخطاب الإشهاري لا تتحقق نجاعتها إلا في ضوء النسق اللغوي فأنظمة الحركة واللباس والموسيقى لا تكتسب صفة البنية الدالة إلا إذا مرت عبر محطة اللغة التي تقطع دوالها وتسمي مدلولاتها، وفي هذا السياق يذهب إيريك بويسنس(E.Bryssens) إلى أن الصورة نسق دلالي قائم بذاته، لها وظيفة أساسة في التواصل ، وليست حشوية فيه ،بالنسبة إلى العلامة اللسانية الطبيعية، بل إن اللغة في كثير من الأحيان تحتاج إلى مثل هذه النظم السيميولوجية لتحقق وظيفتها التبليغية فهي وإن كانت دالة دلالة رئيسة إلا أنها لا تستطيع احتكار الدلالة )) . ويبدو أن ارتباط الخطاب الإشهاري بعوالم المال، والأعمال، والتجارة، التسويق والترويج .. جعله خطابا يقوم على الدعاية والإغراء والقصدية؛ فهو (( لا يشهر من قبيل الصدفة، هو ثقافة مفننة ومقننة، لكنها تراعي ثقافة المرسل إليه أكثر مما تراعي المرسل نفسه، ومن ثم فإن الخطاب الإشهاري موجه أساسا إلى المستهلك أكثر مما هو خاص بالمنتج، وهو بالمعنى التقريري فن، وإبداع .. واع وغير بريء لأنه يكاد يرغم المتلقي إرغاما عل تلقيه بصورة أو بأخرى، نطرا لتضخيم إشكار المنتوج وتجويده، وإضفاء صبغة هائلة من الروعة والجمال )) .. وما يميز الخطاب الإشهاري عن غير من الخطابات الأخرى أنه عندما يكون نسقا إيقونيا (صورة) يراعي ثقافة المستهلك من حيث الدين، والعادات، والتقاليد فما يصلح خطابا إشهاريا في بيئة معينة لها دينها وعاداتها وتقاليدها ولا يصلح في بيئة أخرى مخالفة، لذلك كثيرا ما يجد أصحاب المنتوج المصنع مادة وإشهارا في بيئة أوروبية مثلا مشكلة الإشهار للمنتوج ذاته بالإشهار نفسه في بيئة عربية إسلامية خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام جسد امرأة أو رجل للترويج للمنتوج. 4. مقاربة الخطاب الإشهاري: يتأسس الإشهاري في بعده التأثيري على مبدأ الترويج للسلعة والفكرة المنوطة بها عبر عرض خصائصها ومميزاتها لدفع المستهلك إلى اقتنائها، وهو ما يجعل من العملية الإشهارية تتجسد كفعل اقتصادي اجتماعي يقوم بالدعوة إلى اقتناء منتج معين عبر مستويين أحدهما تقريري يعتمد في بنيته على الإخبار، وثانيهما إيحائي يعمل على إدماج الذاكرة السياقية في سيرورة الدلالة؛ لأن نجاح إرسالية معينة رهين كثافة الشحنات التي تحملها، وصورها الشاعرية الإيحائية، بحيث تكتسي لباساً أنيقاً من المعاني، وتنتقل من طبيعة مادية إلى عالم من القيم والدلالات بفضل تلك الهالة التي يضفيها عليها الإشهاري، فهو عليم بمواطن الإغراء لدى المستهلك (المتلقي)، لأجل ذلك يوظف ما أمكن من الاستعارة، والتشبيه، والكناية، والمجاز، والموسيقى، والحركة، والصوت المشكل، والفضاء، والجسد.. لسلبه حرية الاختيار. وعليه فإنه يمكن تحليل الخطاب الإشهار وفق مقاربات عديدة منها المقاربة اللسانية، المقاربة النفسية، المقاربة التداولية، المقاربة الاجتماعية ـ الثقافية.. طريقة تحليل الصورة الإشهارية فتكون بتجزئة بنيته إلى مكوناتها الرئيسية، ثم إعادة بنائها لأهداف تخدم التحليل؛ لأنّ المقاربات المنهجية الحديثة لا تنحصر وظيفتها في تحليل الخطاب بقدر ما تظهر فعاليتها في كشف الأبعاد الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية للخطاب.. ذلك أن الخطاب الإشهاري يحمل إضافة إلى وظيفة إقناع المستهلك بالمنتوج، قدرة عالية على بلورة الرأي وتشكيل الوعي، والتأثير في الثقافة، لذلك فإن المقاربة السيميائية تعد في رأينا الأنسب لتحليل مثل هذه الخطابات. 5. المقاربة السيميائية للخطاب الإشهاري: وهي أهم المقاربات وأنسبها لتحليل الخطاب الإشهاري، لأنها تجمع بين الصوت، والصورة، والموسيقى، والحركة، والأداء، واللون، والإشارة، والأيقونة، والرمز، واللغة، والديكور .. الشيء الذي يجعلنا نقول إن الخطاب الإشهاري، وخصوصاً السمعي ـ البصري، عبارة عن فيلم قصير جداً يقوم بإنجازه أعوان كثيرون من مهندسين في اختصاصات مختلفة. ثمَّ إننا نزعم أن المقاربة السيميائية تشمل كل المقاربات السابقة وخصوصاً التداولية منها؛ لأن (( افتراض منهجية متكاملة لتحليل الرسائل البصرية تبدو معقدة وصعبة وعلى القارئ ( المشاهد ) أن يكون مجهزا بترسانة من الأدوات الإجرائية التي تمكنه من اكتشاف خبايا الصورة، لأن شروط إعداد وتكوين واستقبال هذه الرسائل تشترك فيه معارف وثقافات من النوع التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والنفسي )) . تتفرع السيمياء إلى فرعين كبيرين هما: سيمياء التبليغ وسيمياء الدلالة ولها اتجاهات كثيرة منها: الاتجاه الإيطالي الذي يتزعمه أمبرتو إيكو ولاندي (Umberto Eco et landy)، والاتجاه الروسي الذي يشمل الشكلانية الروسية ومدرسة تارتو والاتجاه الفرنسي بمختلف تفرعاته، والاتجاه الأمريكي بزعامة بيرس وهو المؤسس الحقيقي للفكر السيميائي الغربي الحديث في نظر بعض الدارسين. تتأسس النظرية السيميائية على عدة عناصر عند بيرس، وهي التطورية الواقعية والبراغماتية وانسجاماً مع هذه العناصر يؤسس بيرس فلسفته على الظاهراتية التي تعنى بدراسة ما يظهر ، وهو بهذا يوسع من نطاق العلامة لتشمل اللغة وغيرها من الأنظمة التبليغية غير اللغوية، فكل ما في الكون بالنسبة لبيرس علامة قابلة للدراسة، خاصة إذا علمنا أن الصورة الإشهارية تهدف إلى إيصال رسالة معينة فهي إذن اتصالية بالدرجة الأولى، وهي موجهة إلى القراءة العامة (destinée la lecture publique) فهي بهذا المنظور حقل مناسب لملاحظة ميكانزمات إنتاج المعاني (production des sens) عن طريق الصورة . ولهذا يعد منظور بيرس الأنسب والأصلح لدراسة الخطابات البصرية ومنها الإشهار؛ فلقد عملت الثورة التقنية في مجال تمثيل وإعادة إنتاج الواقع على قلب تاريخ التمثيل البصري التقليدي… فمن جانب سوف تحتكر الصورة الفوتوغرافية مجموعة مجالات التعبير التي كانت من نصيب الفنون التشكيلية من مثل رسم الطبيعة والصور الشخصية إلى غير ذلك، ومن جانب آخر فإن السينما، والتلفزيون والصورة كمنظومة بصفة عامة ستعمل على تطوير استعمال الطرائق الفوتوغرافية وبخاصة فيما يتعلق بتمثيل الوقائع والمشاهد المتحركة موسعة بذلك من مفهوم الفرجة والعرض اللذين كانا مقتصرين على المسرح فقط، وهذا يعني أن الخطاب الإشهاري بوصفه خطابا يسعى إلى الترويج للمنتوج سوف يمرر رسائل تجد لها متلق يتلقفها دون وعي أو إدراك ويلون بها حياته الثقافية والاجتماعية.. وهنا يكون هذا الخطاب قد تجاوز الوظيفة التجارية إلى صناعة الثقافة. د. عادل بوديار: أستاذ محاضر بقسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب اللغات جامعة تبسة ---------------- مصدر المقال: شبكة ضياء: http://diae.net/50954

29.04.2017
جائزة الملك فيصل العالمية.. رسالة سعودية للسلام وخدمة البشرية- محمد عطيف - الرياض
جائزة الملك فيصل العالمية.. رسالة سعودية للسلام وخدمة البشرية فازت بها 44 جنسية على مدى 39 عاماً بلا عنصرية لجنس أو لون أو عرق بالأمس الجميل توجت جائزة الملك فيصل العالمية جهودها خلال 39 عاماً بمنح الجائزة في فرع خدمة الإسلام لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، كما رسخت منهجاً فريداً في تجسيد مقولة الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -غفر الله له ورحمه- عندما قال: "أرى المملكة العربية السعودية، بعد 50 سنة من الآن، مصدر إشعاع للبشرية". خادم الحرمين الشريفين الذي منحت له الجائزة على خلفية جهوده وعنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واهتمامه بالسيرة النبوية، ودعمه مشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وإنشائه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة لحفظ التراث العربي والإسلامي، وإنشائه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان الإسلامية والعربية. رصانة عالمية: الجائزة التي حافظت على مكانتها كواحدة من أفضل وأقوى وأرصن الجوائز العالمية ومنذ انطلاقتها عام 1399هـ حرصت إلى جانب خدمة الإسلام لتكون أنموذجاً في احترام منجز الإنسان بغض النظر الديانة من خلال بقية فروعها، كما ساهمت في تعزيز خدمة الإسلام والاحتفاء بكل ما يسهم في تقدم البشرية ويخدم الإنسانية. إن نظرة واحدة على 253 فائزاً للأسماء التي فازت بالجائزة في تاريخها لتؤكد على وجود أكثر من 44 جنسية تتمدد على معظم قارات العالم، وتنثر أسماء فازت سواء أو قبل على جوائز عالمية مثل جائزة نوبل العالمية، وجوائز مؤسسة غوردنر وفيلدرز وغيرها. دعوة صداقة للعالم: يقول صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية: "إن عظمة الأمم لا تقاس بما تملكه من وسائل الحضارة المادية، وإنما تقاس بمواقفها الإنسانية من أعمال الخير والبر. قال تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}. مضيفاً: "جائزة الملك فيصل العالمية تأتي عملاً بالمبادئ الإنسانية، التي دعا إليها الدين الإسلامي، وعاش فيصل حياته العظيمة من أجلها، كما تأتي تجسيداً لآماله الكبيرة لرفع شأن العرب والمسلمين". ومؤكداً: "لعلّنا نُقدِّمُ بهذه الجائزة دعوةَ صداقةٍ ومودّة للعالم أجمعْ، ليقفَ معنا على قيم حضارتِنا، وأُسس ثقافتِنا التي تحتفي بالعلم، وتكرِّمُ العلماء، بدون عنصرية لجنسٍ أو لونٍ أو عِرقْ". الدورة الـ39 (2017م): في دورة هذا العام والتي تشكل الـ (39) تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتسليم الفائزين جوائزهم، وهم: - فرع الدارسات الإسلامية: د. رضوان السيد من لبنان نظير جمعه في أعماله ودراساته بين الاطلاع المدقق الواسع على التراث العربي الإسلامي الفقهي والسياسي والإحاطة بمنهجيات البحث الحديثة. - فرع اللغة العربية والأدب: د. خالد الكركي رئيس مجمع اللغة العربية الأردني؛ تقديراً لجهود المتميزة في إدخال التعريب في التعليم الجامعي في الوطن العربي سعياً إلى توطين العلم والتقنية. - فرع الطب: البروفيسور تادامتسو كيشيموتو من اليابان، الذي يشغل حالياً منصب أستاذ المناعة في مركز فرونتير لأبحاث المناعة بجامعة أوساكا باليابان؛ نظير دوره الرائد في اكتشاف وتطوير علاج بيولوجي جديد وناجع لأمراض المناعة الذاتية خلال 30 عاماً. - وسلم الملك المفدى جائزة الملك فيصل العالمية فرع العلوم (فيزياء بالمشاركة) كلاً من: الأستاذ الدكتور دانيال لوس من سويسرا، والأستاذ الدكتور لورينس مولينكامب من هولندا؛ لكونهما من رواد النظرية الخاصة بديناميكية دوران الإلكترونات. - تاريخ الجائزة وآلياتها: يُعدُّ الاحتفال السنوي بتسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها من أبرز جوانب نشاط مؤسسة الملك فيصل الخيرية التي أقامها، عام ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م، أولاد الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله. وبعد عام من ذلك التاريخ قرَّر مجلس أمناء هذه المؤسسة إنشاء جائزة عالمية باسم الملك فيصل. وقد بدأت بثلاثة فروع هي: خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب. ومُنِحت أَوَّل مَرَّة عام ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م. وفي عام ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م أَضُيِفت إليها جائزة في الطب ومُنِحت في العام التالي. وفي عام ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م أُضيفت إليها جائزة في الطب، ومُنحت في العام التالي ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م، وجائزة في العلوم، ومُنحت في عام ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م. وكانت هاتان الإضافتان مما عَمَّق الصفة العالمية للجائزة، وأكسبها مزيداً من الشهرة والنجاح. ويُراعى في منح جائزة خدمة الإسلام ما للمرشح من جهود فكرية أو عملية تخدم الإسلام والمسلمين. وفي اللغة العربية والأدب ما له ريادة وإثراء لهذا الأدب، وفي الطب ما يصوّر الجوانب ذات الاهتمام العالمي. أما العـلوم فتأتي موضوعاتها دورية بين الفيزياء، والرياضيات، والكيمياء، وعلم الحياة. أُطر الترشيح: وتقوم الأمانة العامة للجائزة بدعوة المنظمات الإسلامية والجامعات والمؤسسات العلمية في مختلف أرجاء العالم لترشيح من تراه مُؤهَّلاً في كل فرع من فروع الجائزة الخمسة، كما تقبل الترشيحات من الفائزين السابقين بالجائزة. ولا تقبل الترشيحات الفردية ولا ترشيحات الأحزاب السياسية. وبعد أن ترد الترشيحات إلى الأمانة العامة للجائزة تمر بدورة متفحصة تبدأ من التأكد من انطباق الشروط مروراً بدراسة تقارير الخبراء عنها، وصولاً لاختيار حكام عالميين ترسل إليهم الأعمال المقبولة للترشيح لفحص الإنتاج العلمي وتقويمه وكتابة تقارير عنه في غضون ثلاثة شهور. وصولاً لمنح الجائزة أو حجبها. عن الجائرة: حتى الدورة الأخيرة نال الجائزة بمختلف فروعها -منذ إنشائها- ٢٥٣ فائزاً ينتمون إلى ٤٣ دولة. وتُعلَن أسماء الفائزين بالجائزة، عادة، في شهر يناير من كل عام، كما يُحتَفل بتسليمها للفائزين خلال شهرين من ذلك الإعلان. ويرعى تلك المناسبة خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه، ويحضرها أبرز المهتمين والمتخصصين على مستوى العالم. وتعتبر الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية هي الجهاز التنفيذي الذي يقوم بأعمال الجائزة الإدارية؛ ويتم توجيه دعوات الترشيح إلى الجامعات والمنظمات والهيئات الإسلامية ومراكز البحوث والمؤسسات العلمية في مختلف أنحاء العالم. مكونات الجائزة: تتكون الجائزة في كل فرع من فروعها الخمسة من: براءة من الورق الفاخر مكتوبة بالخط العربي بتوقيع رئيس هيئة الجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، داخل ملف من الجلد الفاخر، تحمل اسم الفائز وملخصاَ للأعمال التي أهّلته لنيل الجائزة. وهي عبارة عن ميدالية ذهبية عيار ٢٤ قيراطا، وزن ٢٠٠ غرام. يحمل وجهها الأول صورة الملك فيصل وفرع الجائزة باللغة العربية، ويحمل الوجه الثاني شعار الجائزة وفرعها باللغة الإنجليزية. شيك بمبلغ ٧٥٠.٠٠٠ ريال سعودي (ما يعادل ٢٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي) ويوزّع هذا المبلغ بالتساوي بين الفائزين إذا كانوا أكثر من واحد. رصانة وقوة الجائزة: حصد الفائزون بجائزة الملك فيصل، عقب نيلهم الجائزة، أهم الجوائز العالمية، منها 18 جائزة نوبل، و8 من جائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية، وجائزتا كيوتو، و5 ميداليات ملكية بريطانية، و8 من الميداليات الوطنية الأمريكية للعلوم، وميداليتا فيلدز في الرياضيات. كما حصدوا أيضاً "3 جائزة أمير أستوريا، و3 جائزة وميدالية شاو، و1 جائزة أبيل في الرياضيات، و1 جائزة جوتفريد ولهلم ليبنتز، و1 جائزة وميدالية ديراك في الفيزياء، و1 ميدالية أديسون، و1 جائزة باور، و2 جائزة وميدالية كرافورد، و2 ميدالية كوبلي من الجمعية الملكية، و2 ميدالية بنجامين فرانكلين، و3 ميدالية لورنتز الذهبية، و2 جائزة مارسيل بينويست، و12 جائزة مؤسسة غيردنر، و4 جائزة مؤسسة ويلش في الكيمياء، و1 جائزة بوليتزر، و2 جائزة ألبرت أينشتاين العالمية في العلوم، و6 جائزة لويس جينتيت للطب، و1 جائزة نيفانلينا في الرياضيات، و1 جائزة فرونتيرز أوف نوليدج (حدود المعرفة) في الطب الحيوي". تاريخ مشرف: الجائزة في سجلها الكبير أسماء لها دور متميز في تاريخ بلدها والعالم أيضاً وأيضاً في تاريخ العلم والاختراعات وتاريخ البشرية، ومن ذلك عدد من ملوك المملكة العربية السعودية في فرع جائزة «خدمة الإسلام» وهم الملك خالد بن عبدالعزيز، رحمه الله، هو أول من حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام في عام 1401، في حين نال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، الجائزة لفرع خدمة الإسلام للعام 1428. كما منحت أمانة الجائزة في دورتها الأخيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجائزة في آخر دورة لها للعام الحالي 2017؛ لتفانيه في خدمة الإسلام والمسلمين. كما تضم القائمة رئيس دولة السنغال عبدو ضيوف للعام 1418، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعام 1431، ورئيس دولة البوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش للعام 1413. وفي قائمة العلماء البروفيسور ديفيد مورلي على أول جائزة في فرع الطب عام 1402، في حين كانت البروفيسورة جانيت أول امرأة تفوز بالجائزة في فرع الطب. وفي فرع العلوم، حقق البروفيسور والعالم المصري أحمد زويل الجائزة للعام 1409، في حين كان السير مايكل جون أول الفائزين بالجائزة فرع العلوم للعام 1406. جائزة الملك فيصل العالمية هي من أبرز النماذج في مجالها والتي تحمل في جوهرها حقيقة المملكة كبلد السلام الأول، ونصاعة الرسالة الإنسانية، من خلال دعمها لكل المساهمين في تطور البشرية ودعم خدمة الدين الإسلامي. ------------------------- صحيفة سبق الإلكترونية: https://sabq.org/3RFb6g
29.04.2017
من فعاليات الملتقى الدولي إنشائيّة التخييل- نجاة ذويب: تونس
دارت أشغال الملتقى العلمي الدولي “إنشائيّة التخييل ” على امتداد يومي 25 و26 أفريل 2017 بكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بالقيروان. وقد شارك في جلساته العديد من الباحثين من الجامعة التونسيّة ومن الجامعة المغربيّة. ساهم الباحث منجي العمري (تونس) بمداخلة عنوانها “المجاز النحوي والدرجة الصفر من التخييل” عالج فيها مسألة المجاز في المباحث التقليديّة وطرح من خلالها بعض الأسئلة من قبيل “هل إنّ الخيال وسيلة جماليّة؟” و”هل إنّ الخيال وسيلة للمعرفة وضرب من العلم؟” وقد توصّل الباحث في ختام مداخلة إلى الدعوة إلى ضرورة مراجعة الموضوعيّة مؤكّدا انّ مسار بناء التخييل في اللغة دائري استيعادي يعيد إنتاج الأشياء في صورة جديدة وبالتالي لا وجود لخيال خلاّق. أمّا الباحث حمروني نبيغ (تونس) فقد قدّم مداخلة بعنوان “عتبات التخييل” بحث فيها عن دور العتبات في الإحالة على متن النص من خلال نصّ طقوس الليل (الجيل 2) لفرج لحوار. وقرأ الباحث فاكر يوسف (تونس) ورقة بعنوان “التخييل في الحكاية بين المعرفي والرمزي” وساهم الباحث أمين عثمان (تونس) بورقة علميّة عنوانها “البنية الفنيّة للتخييل في رواية “العشق المقدنس” لعز الدين جلاوجي. أمّا فعاليات اليوم الثاني من هذا الملتقى العلمي فكانت بجلسة علميّة ترأسها الأستاذ محمد طاع الله وقدّم فيها الأستاذ محمد بن محمد الخبو (تونس) ورقة علميّة بعنوان “كيف يستحيل خبر العشق خبرا نازعا إلى التخييل؟” بيّن فيها الفرق بينا لمرجع والتخييل مبرزا مدى مرجعيّة خبر العشق ودور قصصيّة هذا الخبر في الحديث عن مرجعيّته.وقدّم الأستاذ عبد القادر منسيّة (تونس) ورقة بعنوان “تخييل المعنى عند ابن رشد:المعنى من الغائب والتخييل من الشاهد”. أمّا الباحث محمد إدريس فقد ساهم بورقة عنوانها “أساطير الأوّلين في النص القرآني والنصوص الحواف” في حين ساهمت نوارة محمد عقيله (تونس) بمداخلة عنوانها “التخييل في قصص الأنبياء”. وختم الجلسة الباحث عبد القادر العليمي بمداخلة عنوانها “العتبات النصيّة مدخلا إلى إنشائيّة التخييل”. أمّا الجلسة العلمية الأخيرة فكانت برئاسة الأستاذ محمد بن محمد الخبو وساهم فيها الأستاذ عبد المنعم شيحة بورقة عنوانها “تخييل القلق: قراءة في آليات تسريد القلق في رواية الشحاذ” بيّن من خلالها أهمّ آليات تسريد القلق في عوالم التخييل مبرزا أهمّ أنواع القلق: القلق العادي والقلق الوجودي وهو المحفّز على الإبداع والقلق المرضي وهو المقصود بالدراسة. وقد تناول شيحة القلق من حيث هو مرجع متضخم حتى صار مرضا نفسانيا. وقد بنى الباحث هذه الورقة البحثيّة لبيان كيفيّة أداء القلق، بما هو قيمة نفسيّة، بآليات سرديّة. أمّا الباحثة عفاف الشتيوي (تونس) فقد ساهمت بورقة علميّة عنوانها “إنشائيّة الهامش في سيرة محمد شكري” وساهمت الباحثة عائشة حقي بورقة عنوانها “الكتابة والتخييل:سعيد السنعوسي أنموذجا” تناولت فيها مسألة التخييلي والعجائبي في النص الروائي مبرزة أنّ التخييل في الأدب الغرائبي مضاعف مكتنز يساهم في بناء النص. وقد كان ختام هذه الجلسة العلميّة بمداخلة الباحثة سعاد الجويني (تونس) بمداخلة عنوانها “التخييل عند ابن سينا” درست من خلالها التخييل العرفاني عند ابن سينا مبرزة مدى ارتباطه بالمنطق. كما بيّنت الباحثة في مداخلتها ضرورة الفصل بين الخيال بما هو القوة التي تقبض الصورة والمخيّلة بما هي القوّة التي تعيد تلك الصورة. وقد عقبت هذه الجلسات العلميّة حلقة نقاش موسّعة طرحت فيها عديد الأسئلة من قبيل: هل تخييل خبر العشق من إنتاج المبدع ام من إنتاج المتلقي؟ هل التخييل آلية من آليات تفسير القرآن والعقيدة؟ هل يمكن مقاربة خبر العشق مقاربة وفق الاستعارات الملحّة؟ كيف يتحوّل الهامشي إلى ضرب من إنتاج التخييل؟ ما علاقة خبر العشق بالتخييل؟ هل الخييل سابق أم مزامن أم لاحق لخبر العشق؟ --------------- شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات: http://diae.net/48356
28.04.2017
تعليم اللغة العربية في العصر الرقمي- د. عادل بوديار
تمهيد: يعد التعليم التكنولوجي وسيلة ناجعة في حالة تطبيقه التقنيات الحديثة والمتطورة من خلال إعداد برامج تكنولوجية تتماشى والنظام التعليمي المقرر خاصة أن التطورات الهامة التي حدثت في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي تقنيات الحاسوب والاتصالات السلكية واللاسلكية من توسع لشبكة الانترنت وانتشارها، وظهور لتطبيقات كثيرة ومتنوعة وسهل في الوسائل التكنولوجية أين حاول المختصون في مجال التعليم استثمرها للوصول إلى نظام تعليمي مرن، ومتفاعل مدعم بالتقنيات والبرمجيات الحاسوبية الحديثة لمواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة في عالم التكنولوجيا، ولسد حاجة المتعلم الذي يطمح إلى التحصيل العلمي بأيسر السبل وفي أقل وقت ممكن، ولرفع مهاراته، وزيادة قابليته في اكتساب المعارف والمعلومات. التعليم الإيجابي أو تعليمية المواد : تعد الظاهرة التعليمية من أهم الظواهر التي تحتاج إلى إعادة دراسة وفهم جديدين يقومان على إدراك الواقع، خاصة أن المجتمع الجزائري قد تطور في الزمن الراهن من خلال تفاعل الجيل الجديد مع التطور التكنولوجي الهائل الذي وصلت إليه الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي أثرت في عملية التطور المنهجي للوسيلة التعليمية في المراحل التعليمية المختلفة على العموم، وفي المرحلة الجامعية على الخصوص أين صار الطالب محورا أساسا في العملية التعليمية، لذلك كان لا بد من الوصول إلى طرائق تعليمية ناجعة تستخدم وسائط تكنولوجية فعالة لها القدرة على تقديم المعرفة والمعلومة للطالب بطرق سهلة وجذابة. ويتمظهر مصطلح التعليمية كمفهوم علمي أو كإجراء تعليمي في اللغة العربية في عدة مصطلحات مترجمة في أكثرها عن اللغات الأجنبية ( تعليمية الديداكتيك، تعليميات، علم التدريس، علم التعليم، التدريسية ..) غير أن الصفة التي تشترك فيها هذه المصطلحات هي توكيدها على تشابك العلاقات التعليمية بين أطراف العملية التعليمية؛ لذلك لجأت بعض الدول النامية مثل: المغرب والجزائر إلى عقد شراكة مع دول متطورة مثل الاتحاد الأوروبي لتطوير نظامها التعليمي بمختلف أطواره، فكانت الأهداف الإجرائية لهذا النظام الجديد تنص على (( تعزيز النظرة المتمركزة حول الطالب مع الأخذ بيده من خلال نظام المصاحبة البيداغوجية … والتركيز على التشغيلية … وترقية البعد الاجتماعي للتعليم ))، والاعتماد على التكنولوجيا في العملية التعليمية، لتتحول التعليمية بهذا المعنى إلى (( تقنية شائعة، تعني تحديد طريقة ملائمة أو مناسبة للإقناع أو لإيصال المعرفة ))، بمساعدة التقنية. ومن ثمَّ ظهر ما يسمى بتعليمية المواد أو التعليم الإيجابي في اللغة العربية والذي يتعلق بالمضامين والمناهج والوسائل التعليمية حتى يتم تجاوز مشكلة التلازم بين الجانب المعرفي والجانب البراغماتي اللذان لا يزالان يؤثران في توجيه العملية التعليمية ذلك أن تعليم اللغة العربية ظل لمدة طويلة من الزمن يخضع لاجتهادات فردية أو تقاليد معيارية توارثها المعلمون دون أساس علمي، ولكن اللجوء إلى التعليم الإيجابي في العملية التعليمية لا يعني أنه يمثل نمطا مستقلا بذاته، وإنما هو نظام يستغل الوسائل التكنولوجية للوصول بالعملية التعليمية إلى علم تطبيقي إنساني يحقق نوعا من التزمن بين الوضع الثقافي القائم وسرعة العالم التكنولوجية؛ ذلك أن (( الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي ليس له تأثير كبير في اللغة العربية فحسب، إنما في التعليم أيضاً، فالانفجار المعرفي المتمثل في الزيادة الكمية والنوعية في المعرفة وفروعها يحتم على المؤسسات التعليمية أن تعيد النظر في أسس اختيار وتخطيط وبناء المناهج والمحتوى الدراسي، وأساليب التعامل مع المعرفة، عبر الوسائل التكنولوجية المتعددة، والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة والتقنيات المعاصرة في تطوير مناهج اللغة وتحديث طرائق تدريبها، خاصة أن الاتجاهات الحديثة تتجه نحو الإفادة من معطيات التقنيات المعاصرة في تدريس اللغة وتعليمها. )) الوسائل التعليمية التكنولوجية وجدواها في العملية التعليمية: تعمل الوسيلة التعليمية على زيادة الكفاءة التعليمية والوصول إلى ذروة الاتصال التعليمي داخل حجرة الدرس أو خارجها، لذلك كان لابد لتكنولوجيا تعليم اللغة العربية أن توظف ما أمكنها من الوسائل التعليمية التكنولوجية حتى تكون وسيلة ناجعة في حالة تطبيقها تقنيات حديثة ومتطورة ومتماشية مع التطورات العالمية، ومن بينها هذه التطبيقات إدخال برامج تكنولوجية معدة مسبقا إلى النظام التعليمي المقرر أين يقوم أساتذة مختصون في مختلف تخصصات اللغة العربية بتنفيذه وفق خطة مؤسسة بطريقة علمية، وتعد الوحدات التعليمية الرقمية أحد العناصر الجديدة لنوع من التعلم القائم على الكمبيوتر إذ يمكن استخدامها لأكثر من مرة وفي مواقف متعددة بما يضمن التكرار والتجدد في الوقت نفسه. وقد تدّرج المختصون في تسمية الوسائل التعليمية فكان لها أسماء متعددة منها: وسائل الإيضاح، الوسائل البصرية، الوسائل السمعية .. وأحدث تسمية لها ” تكنولوجيا التعليم ” التي تعني علم تطبيق المعرفة في الأغراض العلمية بطريقة منظمة، وهي بمعناها الشامل تضم جميع الطرق والأدوات، والأجهزة، والتنظيمات المستخدمة في نظام تعليمي بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة؛ لأن (( من أكبر التحولات التي يعرفها العالم المعاصر ـ وخاصة في شروط العولمة والنظام الدولي الجديد ـ ما ينعته ألفين توفلر (Alvin Toffler) بـ”تحول السلطة”،(Power shift) أي تحولها من سلطة للمال والثروة والحكم .. إلى “سلطة للمعرفة” (The power of knowledge) قوامها الأساسي امتلاك الاقتدار المعرفي، والعلمي، والتكنولوجي؛ ولذلك فقد تحولت أساليب وآليات إنتاج وتوزيع واستهلاك، وتوظيف المعرفة إلى “صناعة للمعرفة” (Industry knowledge) مخططة وهادفة، ومؤكد أن حقول التربية والتكوين تعد بامتياز ـ إضافة إلى حقول ومجالات أخرى، كالإعلام والاتصال والمعلومات .. ـ أهم حقول هذه الصناعة المعرفية، وذلك على اعتبار أن مشاريع التعليم والتكوين قد أصبح ينظر إليها على أنها بمثابة “الهندسة الاجتماعية” (Social engineering) التي تتحدد وتتراتب فيها، بشكل عقلاني منظم، أنماط الأهداف والأولويات والرهانات ))، إذ لم يعد متعلم اللغة العربية ذلك المتعلم الموثوق إلى طريقة الأستاذ المعلم، بل صار بإمكان متعلم اللغة العربية أن يجد القواعد جاهزة وفق أنظمة معلوماتية تسهل عملية الفهم وتختصر عمل المعلم في وضعيات إدماجية تتيح للمتعلم توصيل القاعدة بالمثال في النحو أو الصرف أو البلاغة أو العروض. دمج تقنية المعلومات والاتصالات في تعليم اللغة العربية: يسعى المشرفون في مجال تعليم اللغة العربية إلى استحداث أفضل الطرق للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة كالحاسوب، والشبكات، والوسائط المتعددة من أجل إيصال المعلومة للمتعلمين بأسرع وقت وبأقل تكلفة، وبصوره تمكن من التحكم في العملية التعليمية، وقياس مردود المتعلمين (( أين تم إدخال مفهوم الوسائط الترابطية كمفهوم جديد على مفاهيم تكنولوجيا التعليم والذي يعمل على دمج عناصر الوسائط المتعددة في برامج تعليمية حاسوبية في نصوص او رسالات تعليمية فعالة، أي من خلالها يمكن تزويد الطالب بمناخ تربوي تعليمي تتوفر فيه مصادر عدة لتكون في نسق نظامي واحد ومرتب ))، لذلك نجد أن كثيرا من الدول العربية كانت قد استخدمت أنواعا من أنظمة التعليم فيما يخص تعليم اللغة العربية لما تتميز به تلك الأنواع من مواصفات تسهل العملية التعليمية وتصل بالمتعلم إلى أفضل درجات الأداء، ومن هذه الأنواع الناجعة نجد: التعليم الالكتروني: (E-Learning) يعد التعليم الإلكتروني النظام التعليمي المستقبلي المتكامل الذي سيكون بديلا أساسيا وطبيعيا عن النظام التعليمي التقليدي؛ لأنه عبارة عن منظومة متكاملة من المعطيات، والمفاهيم، والأدوات التفاعلية المتوفرة في بيئة التعليم، ولأهمية هذا النوع من التعليم ظهر في السنوات الأخيرة الكثير من المصطلحات الجديدة في ميدان التعليم، وطرحت حولها مجموعة من المفاهيم، والتحديدات، والتصورات مثل: التعلم الالكتروني (eLearning) والتعلم المتنقل (mLearning) وغيرها، ويمكن تعريف التعليم الإلكتروني بأنه: (( التعليم الذي يُقدم المحتوى التعليمي فيه بوسائط الكترونية وباستخدام آليات الاتصال الحديثة كالحاسوب والشبكات والوسائط المتعددة من أجل إيصال المعلومة للمتعلمين بأسرع وقت، وبأقل كلفة، وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء المتعلمين )). وهذا يعني أن التعلم الإلكتروني منظومة تعليمية عامة تقدم البرامج التعليمية في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات مثل: ( الإنترنت، الإذاعة، القنوات المحلية أو الفضائية للتلفاز، الأقراص الممغنطة، البريد الإلكتروني، أجهزة الحاسوب، المؤتمرات عن بعد…)، وهو أيضا يحقق بيئة تعليمية تفاعلية متعددة مصادر المعرفة والمعلومة بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة ( عن بعد ) دون الالتزام بمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي من جهة، والتفاعل بين المتعلم والمعلم من جهة ثانية حيث يمكن تقديم الحاسب الآلي (computer) كوسيلة مساعدة في العملية التعليمية؛ لأن (( … النظم الآلية تفرض على الموضوع الذي تعالجه … انضباطا واكتمالا يتعذر دونهما إخضاعه لمنطق الآلة وحسمها القاطع ))، وذلك يتطلب معرفة جيدة بطريقة صياغة المناهج التعليمية بشكل دقيق وقابل للقياس، وكذا معرفة مستويات المتعلمين وقدراتها العقلية والحركية والانفعالية…؛ لأن قدرة المستخدم ( المتعلم ) على تحديد هذه حاجياته المعرفية يساعده على الاختيار السليم للوسيلة التي تحقق له التحصيل الصحيح، غير أن ما يشوب هذا النوع من التعليم وجود بعض الحواجز التي قد تحول دون الوصول إلى نجاعة التعليم خاصة فيما يتعلق بالتكلفة الباهظة، ونقص الكفاءة، وينقسم التعليم الالكتروني إلى نوعين: أولا: التعليم الالكتروني التزامني (Synchronous E-Learning): وهو التعليم الذي يتزامن فيه وجود المتعلمين والمعلم أمام أجهزة الحاسوب في عبر غرف المحادثة (Chatting)، أو تلقى الدروس من خلال الفصول الافتراضية (Virtual classroom) وهو مناسب جدا في الدروس النحوية، والصرفية، والبلاغية أين تتم عملية تواصلية بين المستخدم (المتعلم/ المعلم). ثانياً: التعليم غير التزامني: (Asynchronous E-Learning) وهو التعليم الذي لا يتزامن فيه وجود المتعلم أو المعلم ويتم عن طريق بعض وسائط التواصل الاجتماعي كالبريد الالكتروني أو الفايس بوك … وهذا النوع من التعليم مناسب لطرح انشغالات وأفكار وتحليل قضايا لغوية أو أدبية. التعليم الإلكتروني التفاعلي الذكي: ( E-learning interactif intelligent) التعليم الإلكتروني التفاعلي الذكي هو أسلوب جديد متطور، وتطلع مستقبلي يسمح للمعلم والمتعلمين بالتفاعل مع بعضهما البعض بشكل مباشر وآني، ويسعى القائمون على هذا النوع من التعليم في بعض الدول العربية إدماجه في مجال تعليم اللغة العربية من أجل الوصول إلى تعليم متكامل العناصر والفعاليات بدءاً من تصميم المنهاج الدراسي التفاعلي، ومرورا بتحفيز المتعلم وترغيبه في العملية التعليمية، وانتهاء باستحداث نظام امتحانات يمكن من تقييم المتعلم، حيث يركز التعليم المستقبلي على مهارات المعرفة الشاملة، والمعرفة المتخصصة في آن واحد، وذلك من خلال الاستفادة من نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها لإثراء كافة مراحل التعليم بالمصادر والحلول التقنية والتعليمية اللازمة إضافة إلى استخدامه للمعايير والمواصفات التعليمية العالمية وتأكيده على تقييم مخرجات وجودة التعليم بشكل دائمي ومستمر من خلال استخدام إدارة المعرفة (Management Knowledge ) والمشاركة الفعالة، والواسعة للمتعلمين كجزء أساسي لبناء المهارات التخصصية والمعرفية اللازمة لهم. وفي هذا الإطار طورت بعض الجامعات في كندا وفي بعض المؤسسات التعليمة الأوروبية طرائق تعليمها وصممت بوابات متخصصة في تقنيات التعليم الإلكتروني التفاعلي الذكي، ومثال ذلك بوابة التعليم ( Clever© ) التي تعتمد على منظومات الكترونية تفاعلية، وأدوات تعليمية حديثة، وبرمجيات متخصصة من الجيل الثاني مرتبطة بمحافظ تعليمية مرنة مزودة بخصائص التطور التكنولوجي، أضف إلى ذلك فإن بوابة التعليم الإلكتروني الذكي توفر ما تحتاج إليه المؤسسات التعليمية من برمجيات، وأجهزة تدريسية، وسبورات الكترونية تفاعلية ذكية من الجيل الثاني (e-Learning2.0) وهي تتميز بسهولة الاستخدام والانسيابية في التعامل معها كالسبورة المدرسية الاعتيادية، ولكنها ومزودة بإمكانات وتقنيات تعليمية متطورة، وسيرفرات، ووسائل ومصادر التعلم اللازمة وهي جميعا مرتبطة بحزمة الكترونية متكاملة واحدة تعمل من خلال شبكة الانترنت أو من خلال الشبكة الداخلية للمؤسسة التعليمية LAN. ويمكن أيضا الاستفادة من تكنولوجيا التعليم الالكتروني التفاعلي الذكي باستخدام نظام بلازا للفصول التدريسية الإلكترونية التفاعلية (Plaza system of electronic interactive teaching classes) وهو نظام من أفضل نظم اللقاءات المرئية (video conferencing) حيث يعمل النظام مع انترنيت بسرعة 28.8ك، ويستوعب عدد 32 مشارك في الوقت نفسه، فيتمكن جميع المشاركين من استخدام كافة الإمكانات المتوفرة من صورة، وفيديو، ومحادثة مكتوبة .. ويمكنهم جميعا من المشاركة في التطبيقات من خلال التصفح الاعتيادي الذي يعمل بشكل تلقائي في تنزيل البرنامج المطلوب عند المشاركة لأول مرة. ج- التعليم الجوال أو المتنقل ( Mobile Learning ): يعرف كوين (Quinn) التعليم الجوال أو المتنقل المتنقل بأنه: التعلم الإلكتروني باستخدام الأجهزة المتنقلة: البالم، وآلات الويندوز سي أي، وأي جهاز تليفون رقمي والتي يمكن تسميتها أدوات المعلومات”؛ إنه استخدام الأجهزة المتحركة (Mobile Devices) والأجهزة المحمولة باليد(Handheld IT Devices) مثل الأجهزة الرقمية الشخصية ( Personal Digital Assistants)، والهواتف النقالة (Mobile Phones)، والحاسبات المحمولة (Laptops)، والحاسبات الشخصية الصغيرة. وهذا النوع من التعليم يدخل ضمن فكرة ما يسمى بدمقرطة التعليم وهو يتطلب تأسيس شبكة وأجهزة لاسلكية متنقلة تساعد في عملية الاتصال والتواصل؛ وفي هذا النوع من التعليم يحرر المتعلم من حجرة الدرس ويعطيه هامشا من حرية أداء وظائف متنوعة ومختلفة في وقت واحد: كأن يتعلم المتعلم وهو يؤدي وظائف مختلفة في الوقت نفسه، وفق مبدأ مرونة التعليم عن بعد؛ أي إن هذا التعليم هو (( النقطة التي تتفاعل فيها الأجهزة المتنقلة مع التعلم الإلكتروني ليثمر ذلك خبرة تعلمية (Learning Experience) تحدث في أي وقت وفى أي مكان ))، وهذا يعني أن انتشار استخدام الأجهزة الذكية بين من فئات كثيرة من أفراد المجتمع إلى درجة المبالغة والإدمان أحيانا يجعل من الضروري استثمار هذه التوجه الاجتماعي الجديد إيجابيا وتحويل الإقبال على التكنولوجيا إلى فتح جديد في مجال الثورة المعرفية والمعلوماتية، وتوظيف التطبيقات التكنولوجية الجديدة إلى مهارات تسهم في إثراء الجانب المعرفي والعلمي للمستخدم ( المتعلم ) وتزيد في تعلقه وإقباله على العملية التعليمية. ويذكر ديسموند كيجان (Desmond Keegan) أن: (( الهدف من خلق بيئة تعتمد على المتعلم المتنقل هو زيادة مرونة التعليم عن بعد والتي تراجعت خطوات للوراء ـ إلى حد ما ـ حينما تحولت من التعليم المعتمد على الكتب والأوراق إلى التعلم الذي يعتمد على الإنترنت، وهو ما يتطلب أن يجد الطلاب المكان والوقت وجهاز الحاسب الموصل مع الانترنت )) حيث تعزز هذه الوسيلة الدافع والالتزام الشخصي للتعلم، فإذا كان الطالب سيأخذ الجهاز معه إلى البيت في أي وقت يشاء، فإن ذلك سيساعده على الالتزام وتحمل المسئولية، زد على ذلك أن هذه الأجهزة الرقمية الشخصية، والهواتف النقالة قد تؤدي إلى سد الفجوة الرقمية لما توفره تلك الأجهزة من تكلفة أقل مقارنة بتكلفة الحاسبات المكتبية. وهذا لا يعني أن التعليم التكنولوجي بما يوفره من مرونة التعليم وسهولة في الاستخدام هو تعليم مجاني دون كلفة، بل إننا نجد أن بداية التأسيس للبنية التحتية في التعلم الإلكتروني والتعلم المتنقل قد يحتاج إلى تكلفة عالية حيث يتطلب أنموذج التعلم الإلكتروني حاسبات مكتبية، وإنتاج برمجيات تعليمية، وتصميم مناهج إلكترونية تنشر عبر الإنترنت، ومناهج إلكترونية غير معتمدة على الإنترنت، وتدريب المعلمين والطلاب على كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة المستخدمة، كما قد يكون التعليم المتنقل بحاجة إلى توفير بيئة تفاعلية بين الأساتذة المختصين في المواد التعليمية والمساعدين على استخدام الأجهزة من جهة، وبين الطلبة من جهة أخرى، وكذلك بين الطلبة أنفسهم. الكتاب الإلكتروني: (E-book) لا يخفى على أحد وجود تلك الصفحات المتسعة على شبكة الإنترنت الدولية التقنية المسماة بالكتاب الإلكتروني، وفيه يتم تخزين محتوى الموضوعات التي يراد تقديمها للطالب على قرص مدمج، يتم مشاهدته على شاشة الكمبيوتر العادية داخل حجرة الدرس ويتم التحكم من ناحية الطالب باستخدام مؤشر الفارة للانتقال من فصل لآخر ومن صفحة لآخر ومن سطر لآخر، وهذا البرنامج عادة ما يجمع بين المعلومات أو البيانات المقروءة أو المكتوبة والرسوم والصور الثابتة والمتحركة والمؤثرات الصوتية والصورية، ولو تم تأليف (إنتاج) كتب إلكترونية في مجال تعليم اللغة العربية فإن ذلك سوف يقدم خدمة جليلة لمتعلم اللغة العربية لما سيوفره من مستلزمات فهم الدرس وتخزينه، وهذا ما يجعل عملية الاسترجاع فيما بعد أسهل نظرا للممارسة الفعلية للمعلومات المقدمة لا استقبالها فقط. الوسائط المتعددة: (Multimedia) الوسائط المتعددة أو ما تعرف بالملتيميديا؛ وهي عبارة عن مصطلح لوصف اتحاد البرامج والأجهزة التي تمكن المستخدم من الاستفادة من :النص، والصور، والصوت، والعروض، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو، وتعنى الوسائط المتعددة بعرض المعلومات في شكل نصوص مع إدخال كل أو بعض من العناصر التالية :الصوت والصور الرقمية، والرسوم المتحركة، ولقطات الفيديو الحية خاصة في تدريس بعض المقاييس التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتجربة أكثر من ارتباطها بالتراكم المعلوماتي أو المعرفي. ومن الخدمات التي تقدمها الوسائط المتعددة في تعليم اللغة العربية أنها تصل بالعملية التعليمية إلى مبتغاها وتجعل العملية التعليمية ممتعة وشيقة، فتهيئ فرصا جديدة لتيسير الحصول على المعلومات عن طريق استثارة أكبر قدر من الحواس البشرية، وقد (( أثبتت المنجزات التي تمت على صعيد اللغات الأخرى ما لتزاوجها مع الحاسوب من قدرة فريدة على إكساب هذه اللغة مزيد ارتقاء وكفاءة وحيوية ومرونة وخصوبة ومنطقية وصمودا للزمن، قياسا على ذلك لنا أن نتصور ما يمكن أن يؤديه الحاسوب في تعويض تخلفنا اللغوي؛ تقعيدا، وتنظيرا، واستخداما ))، ثم إن هذه الوسائط المتعددة توفير الوقت الكافي للمتعلم ليعمل حسب سرعته الخاصة، ويتزود بالتغذية والقدرة الفورية على الاسترجاع، مما يساعده على مساعدة على معرفة مستواه الحقيقي من خلال عملية التقويم الذاتي، بل إن المتعلم نفسه يمكن أن يتوصل إلى تأليف برنامجه الخاص باستخدام خصائص الوسائط المتعددة لعرض أعماله ومشاريعه، ثم إن هذه الوسائط المتعدد قد تستخدم من أجل تحقيق تفاعل المتعلمين مع بعضهم البعض، وهو ما يكسبهم القدرة على التحكم مع بيئة التعلم “. ------------------ مصدر المقال: موقع المجلس الدوليّ للغة العربيّة: http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=10467

28.04.2017
حماية اللغة العربية مسؤولية وطنية- د. إنتصار البناء
وجهت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين جميع المدارس إلى ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية في كافة عمليات التدريس عدا تعليم اللغات. ويأتي هذا التوجيه استمراراً لجهود الوزارة في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز استخدامها في المدارس والاحتفاء بها في المناسبات الخاصة بها وإثراء استخدام الطلبة لها في المسابقات الخطابية والإبداعية والأنشطة المصاحبة لذلك. وفي سياق الاهتمام الرسمي باللغة العربية، اطلعت على قانون حماية اللغة العربية الصادر عن مجمع اللغة العربية بالأردن والمنشور في الجريدة الرسمية. وهو قانون يلزم جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وجميع المؤسسات التجارية باستخدام اللغة العربية في كافة معاملاتها وتعاملاتها والوثائق الصادرة منها. والقانون ينظم حاجة بعض المؤسسات خصوصاً الصناعية والإعلامية باستخدام لغة أجنبية بضرورة إرفاق الترجمة مع إبراز اللغة العربية بخط أكبر وأكثر بروزاً. والقانون يفرض غرامة مالية على من يخالف مواده، وبالفعل تم تحرير مخالفات لمئات المحلات التجارية لهذا السبب. وقيمة التوجهات البحرينية في مجال التعليم أنها تغرس في الطلبة حب اللغة العربية والإيمان بها وبعلاقتها بالهوية الوطنية منذ بداية نشأتهم، وأنها تخفف من حالة الغربة بين اللغة الفصحى واستخدامات الطلبة للهجات المحلية أو اللغة الأجنبية في مجالات حياتهم اليومية. فيضمن التعليم تخرج طلبة معتزين بلغتهم قادرين على استخدامها استخداماً وظيفياً وإبداعياً. أما التجربة الأردنية فهي تنظم حضور اللغة العربية الرسمي في التعليم ووزارات الدولة ومؤسساتها، والمؤسسات والمحال التجارية والاقتصادية الحكومية والخاصة. وكلا التوجهين بالإضافة إلى العديد من الجهود التي تبذلها باقي الدول العربية، يصب في سبيل الحفاظ على اللغة العربية وحماية كينونتها من الانزواء أو الهجر أو الانكفاء على الاستخدام الرسمي ودواعي المقدس الديني. فاللغة العربية بالنسبة للمواطن العربي ليست أسلوب تواصل فحسب، بل إنها أداة ثقافية عميقة العلاقة والروابط مع التاريخ والجغرافيا والامتداد الديمغرافي لكتلة كبيرة من المواطنين العرب. والتجارب السابقة تؤكد أن الدور الحكومي الرسمي في الحفاظ على اللغة العربية لا يتوقف عند تعليمها في المراحل الأساسية بل يتجاوز ذلك إلى الحفاظ على استخدام العربية الصحيح في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية. ---------------- مصدر المقال: موقع المجلس الدوليّ للغة العربية: http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=10465
لتكن على تواصل دائم معنا بالاشتراك بالقائمة البريدية
لا تترد في التواصل معنا لأية اقتراحات أو استفسارات